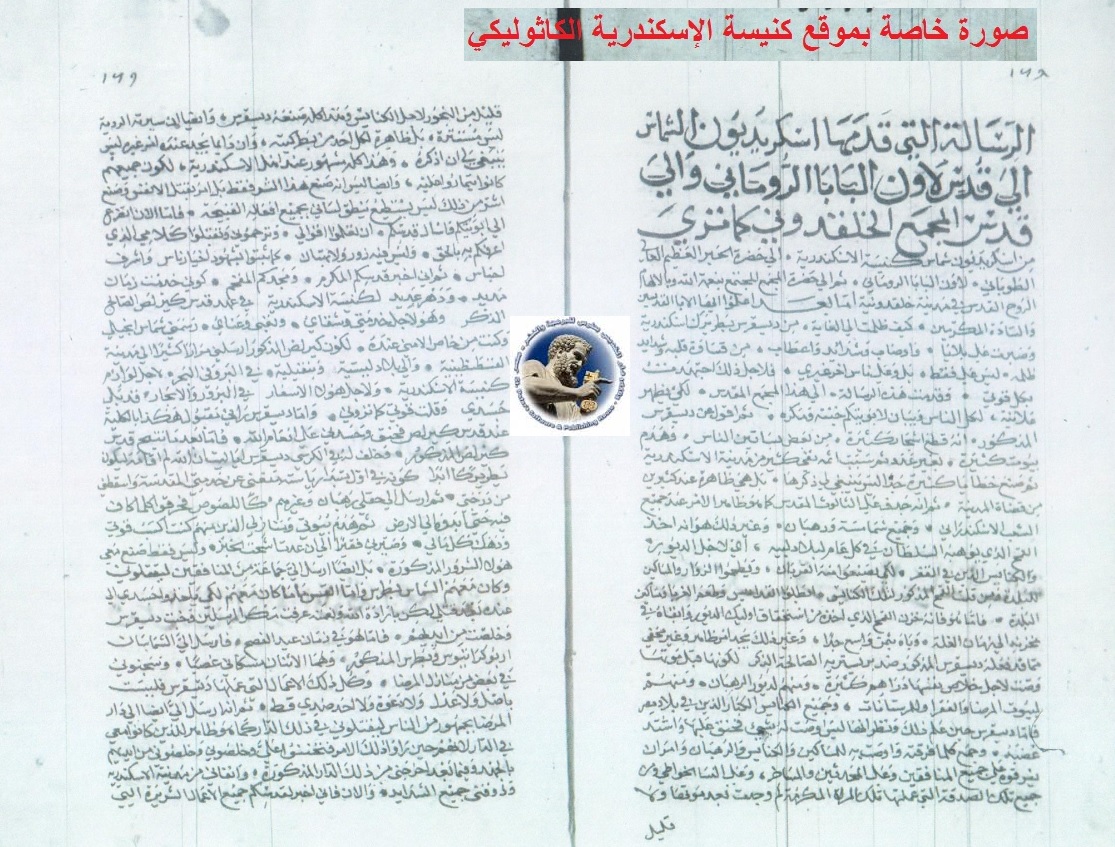الفكر الإسكاتولوجي للكنيسة الكاثوليكية مع مقارنته لبعض أفكار أوريجانس
إعداد الأب الياس جانجي
روما، الثلاثاء 13 يناير 2009 (Zenit.org).
ننشر في ما يلي دراسة الأب الياس جانجي حول موضوع "الفكر الإسكاتولوجي للكنيسة الكاثوليكية مع مقارنته لبعض أفكار أوريجانس".
* * *
المقدمة
إن أسطورة التقدّم الحاليّة، التي غذتها الحضارة التقنيّة والتي ما زالت تغذي العديد من الأحلام البشريّة حاولت أن تحل لغز الموت الذي لا يزال يقض مضجع الإنسان، هدفها من كل ذلك أن تلغي كل اعتقاد بوجود شيء ما بعد الموت: فالطب مثلاً يحاول أن يؤخر الموت قدر المستطاع وهذا ما يسمونه "التكالب على العلاج" (acharnement thérapeutique) وهو يقوم على حفظ المريض في قيد الحياة إلى أقصى الحدود وأحيانًا بتجاوز الحد المعقول بواسطة الطرق الإصطناعيّة. إلا أن هذه الحضارة أفرزت خيبات أمل متتالية، ولم تستطع حتى اليوم أن تريح الإنسان من قلق الموت ولا من قلق ما بعد الموت. فما هو مضمون رجائنا بعد الموت، وإلى أي أساس يستند؟
في هذه الدراسة سنحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمور النهيويّة، أي المختصّة بالماورئيّات وكل ما تتضمنه من مواضيع كالموت والقيامة والحياة الأبديّة والسماء والمطهر وجهنم وغيرها، مع عرض سريع لفكر أوريجانس الاسكاتولوجي. همنا من خلال هذه الدراسة ليس المعلومات العامة فقط بل أيضًا تقديم مفهوم مسيحي لاهوتي لكل هذه المواضيع، وإعلان الرجاء لإنسان اليوم المملوء باليأس وبخيبات الأمل التي يختبرها في حياته اليوميّة.
لهذا لا بد لنا من إعطاء توضيح محدد لكلمة الإسكتولوجيا أو الأخيريّة أو النهيويّة، فهي كلمة منحوتة من الأصل اليوناني (eschatologie)، تدل على معرفة الحقائق الأخيرة. وبالمعنى الحصري تعني هذه الكلمة نهاية الأزمنة والدينونة الإلهيّة وعودة المسيح. ولكن بما أن الأبديّة حاضرة منذ الآن بفضل قيامة المسيح، فغالبًا ما تعني الإسكتولوجيا حضور المسيح القائم من الموت في عالمنا، وكل ما ينتج عنه، ولا سيما حضور الروح القدس على وجه فعال، بصفته يحول الإنسان منذ الآن بالنعمة، ويحول غير الإنسان، الكون كله. وبهذا المعنى فالإسكتولوجيا هي حاضرة منذ الآن في العالم، ولكنها ليست تامة بعد. لذلك فإننا أعطينا عنوانًا آخر لِهذا الموضوع وهو "الحياة الدائمة مع المسيح"، هذه الحياة التي تبدأ على الأرض وتستمر في الأبديّة.
أولاً: فكر أوريجانس الإسكاتولوجي
ـ حياة أوريجينوس[1]: وُلد أوريجانس سنة 185 من عائلة مسيحية ميسورة في الإسكندرية، تابع دروسه في معهد الاسكندرية الشهير على يدّ إكليمنضوس الاسكندري، لما اشتدت عمليات الاضطهاد التي قادها سبتيموس ساويروس سيق والده إلى الاستشهاد، فهب الابن الشاب لمرافقة والده والاستشهاد معه، إلا أن تدخل والدته عارض هذه الفكرة. سعى أوريجانس بفضل ثقافته لتأسيس مدرسة مستقلة، وأوكلت إليه فيما بعد مهمة تعليم وتهيئة طالبي العماد. لكنه ما لبث أن تخطى هذا الإطار ليرئس مدرسة الديداسكالي التي كانت انطلاقة حياة أوريجانس وشهرته. سنة 250 اشتعلت جذور الاضطهاد بقيادة الإمبراطور داقيوس. فكان أوريجينوس من عداد المستهدفين. إلا أنه توفي في مدينة صور بعد أن عانى الأمرّين من العذابات.
فكره: تحدث أوريجانس عن مسألة النهايات (الإسكاتولوجيا) في معرض كلامه على الخلائق عامة، وفعل ذلك أيضاً في معرض كلامه على المادة، أما هنا هو يخصّ الإنسان بالذكر. فكان لا بدّ من ذكر تعليم الإيمان الموروث في أيامه. فيفتتح الجدل في مسألة البعث، ثم يتناول موضوع العقاب، ويأتي آخراً إلى الكلام عن المواعيد التي وعد الله بها الإنسان. ولكن هذا الأخير لا يستطع أن يبقى ثابتاً ومؤمناً بهذه المواعيد طالما تتقاذفه أمواج الحياة.
ينطلق أوريجانس في حديثه عن الحياة الخالدة من بديهية تُعتبر أساس كلّ تفكير فلسفيّ ولا سيما المذهب الوجوديّ، حيث يأخذ «وجود» الكائن البشريّ بالدرجة الأولى، وذلك بتأكيد ضرورة الحركة لدى الكائنات الحية، وبالأخص لدى الإنسان. فيطرح ثلاثة أنواعٍ من النشاطات البديهيّة التي يفعلها أحياناً: الأول سخيف، والثاني حسن، والثالث يُعتبر جيداً لِـ «وجود» الإنسان. فهو تارة صريع الملذات؛ وهو طوراً شغف بخير الجماعة، فيجري في طلب الإصلاح؛ وهو طالب يسعى في كشف الحقيقة والسعي إليها. يعتبر هذا العمل الأخير أساس غاية وجود الإنسان، حيث أنه يسعى إلى أن «يدرك ما وراء الوقائع الجسميّة» أي أن يبذل جهداً بشرياً لكي يعرف نفسه والله. وبالتالي فإن هذه المنهجية في التفكير التي تُدعى بـ «الفلسفة» تُكسب الإنسان معرفة غاية وجودّية. فمعرفة حقيقة الأشياء تبدأ من عللها وطبيعتها. ولذلك ينطلق أوريجانس من دراسة نمط العيش ومستواه ليبحث في «عين الحياة» أي في الحياة الخالدة. فتكون الغاية في بحث جدّي عن حالة الإنسان في «الحياة الحقة»، حيث أنه إذا كانت حالة الإنسان على ما سبق وصفه، أتكون حاله كذلك في «الحياة الحقة»، أي في المسيح.
فيما يلي يأتي ذكر أصحاب البدعة الألفية[2] وهم الذين يماثلون عالم الآخرة بعالم الدنيا، حيث أنهم يناشدون بضرورة إتمام الملذات الجسدية متشبّثين بمعنى الشريعة الحرفيّ على نحو سطحيّ. فيذكر بذلك أولئك الذين يتوقون لأن يجدوا لهم في القيامة جسداً لحميّاً ثانياً، يتيح لهم الإقبال على المأكل والمشرب وعلى كل فعل يمتّ بصلة إلى اللحم والدم. ويتأملون عقد الزواج وإنجاب البنين بعد القيامة أيضاً. ويشدد على ذلك مؤكداً على ذكرهم آيات من الكتاب المقدس، فيضمنون لأنفسهم الخدمة المريحة، ويحسبون بأنهم سوف يتسلمون خيرات الأمم. فبالتالي يريد أصحاب هذه البدعة في هذه الفانية ما يرجونه من تمام المواعيد.
بعد ذلك يتكلم أوريجانس عن العلم الذي يتلقاه الناس، وعن المعرفة الناقصة التي يغادرون بها الحياة. فإذا كانت مرفقة بأعمال صالحة، فيتهذبون في أورشليم السماوية. كل ما يكون الإنسان قد قاساه على هذه الأرض بجرأة وتقوى من معارك فهو سيصيب في العلى معرفة أسمى، لأن الإنسان لا يحيا من الخبز وحده، وإنما من كل كلمة تخرج من فم الله أيضاً.
يبدأ أوريجانس بتفسير مواعيد الله لأصحاب البدعة الألفية تفسيراً روحياً، ينأى عن الإسفاف في الرؤية. ويضرب في سبيل ذلك تشبيهاً: المعجب الذي أخذت منه الدهشة مأخذاً إزاء تحفة عاينها، تغلو به حميته ويدفع به الفضول لكي يعلم أسرارها، ويعلم بحكمة صانعها. كذلك سيصير بالخليقة متى صار مآلها إلى الحياة الأخرى. فإنها تعبر الحيز تلو الأخر وهي ترتوي من معرفة أسرار الله، دون كلل ولا شبع. وهي ستستمر بالصعود في سلم المعرفة حتى تمسي كلها إدراكاً ومعرفة، مستعيدة حال كونها الأول. فإذا سارت إلى هذه المرتبة من المعرفة الباسقة في سموها، المنيعة على قوى التيه والضياع، أمكنها حينئذ من التأمل في حقيقة الله، والارتياح إلى معرفته؛ فتلبث فيه. ويعطي أوريجانس أمثلة أخرى عن معرفة أسباب عمل الله. وبعدها ينتقل إلى الكلام عن المعرفة بعد الموت ويستشهد بقول أحدهم: «إني واقع بين أمرين، إذ بي رغبة لكي أموت فأكون مع المسيح، وهذا لأفضل إلي جداً»[3]، وذلك ليبين عن المعرفة التي تلي الموت، معرفة الأحياء والأموات.
إن فكرة الخلاص عند أوريجانس محاطة بفكرة الخلق الجديد، حيث أنه عودة إلى حالة النقاء الأولى. وقد استقى تفكيره من فكر القديس بولس في رسالته إلى كورنثوس[4]: «ومتى أخضع له كل شيء، فحينئذ يخضع الابن نفسه للذي أخضع له كل شيء، ليكون الله الكل في الكل». فالكمال الذي يترجى هو واحد، فُقدت صورته بالخطيئة، فأعادها المسيح إلى سابق عهدها. وفي هذا لا يستثني أوريجينوس أحداً بل يعتبر أن الكلام مطبق على كل كائن، الشيطان كان أم الموت، أم الخطيئة. كما أنه لا يميز بفكره بين صيرورة المخلوقات إلى حالها بفعل قواها، وإخضاعها لله بفعل المسيح فيها. كذلك، ليست حالتها عند حصول الخلاص لها مساوية لحالها وهي موجودة عند الله
من خلال ما سبق نستطيع أن نستنتج فكر أوريجانس حول الآخرة[5]:
1. المعاودة (الإعادة الشاملة إلى الوضع السابق): يتحدث أوريجانس عن نوعين من النفوس، فالتي أخطأت على هذه الأرض ستُطهر بالنار بعد موتها، أما نفوس الأخيار فستدخل إلى الفردوس، حيث سيأتي الله ويحل جميع المشاكل العالقة في الكون. وسينال جميع الخاطئين الخلاص. أما الشياطين وإبليس نفسه فسيطهرهم الكلمة (اللوغوس). وبعد أن يتم ذلك، يكون مجيء المسيح الثاني، ثم قيامة جميع البشر، في أجساد غير مادية، بل روحية، فيكون الله كل شيء في الجميع. «وستتم نهاية العالم والانقضاء الأخير، حين يكون كل واحد قد تحمل عقاب خطاياه. والوقت الذي يجازي الله فيه كل واحد بحسب استحقاقاته لا يعرفه إلا الله. ورأينا أن عطف الله سيعيد، بمسيحه، جميع المخلوقات إلى نهاية واحدة، حتى أعدائه، بعد أن يكون قد استمالهم وأخضعهم»[6]. فالإنسان حين يعود إلى المسيح سيعرف أسباب كل أمر يجري على وجه الأرض، بما له شأن بالإنسان وبالطبيعة وعلم الإلهيات.
2. وجود النفوس السابق: يعتقد أوريجانس بأن الله قد خلق كل النفوس في البدء، حيث أنها كانت متساوية ومتحدة في مشاهدة الثالوث. لكن وبسبب بعض الثقل الذي استولى عليها بردت همتها في المشاهدة، فسقطت وابتعدت عن الله وعن بعضها. فالفرق بين هذه النفوس أي بين الملائكة والبشر، لا يعود إلى فرق في الطبيعة، بل إلى اختلاف في التأهب الباطني. فالمادة ليست سبب سقوط الأرواح بل نتيجته. عند هذا السقوط قام الله بخلق طبيعة أخرى، وهي الكون الحسي الذي يتيح للطبائع الناطقة المتجسدة أن تستعيد عن طريق المحنة صفائها الأصلي. ولهذا من الضروري وجود عدة عوالم يختلف بعضها عن بعض، حيث أن تطهر الأرواح لا يمكن أن يتم بإقامة واحدة في العالم الحسي، ذلك بأن بعض الأرواح يزيدون سقوطهم سوءاً، ومنهم من ينهضون بوجه غير كامل.
في الأصل خلق الله عدداً معيناً ومناسباً من الأرواح، من صفاتها أنها مفطورة على الحرية[7]. لكن الله يستطيع أن ينتصر على الأرواح الشريرة ويستطيع أن يردها إلى نفسه، فتصبح إرادتهم الشريرة إرادة صالحة. فالنهاية الأخيرية ستكون مطابقة للأصل. هذا المبدأ هو من مبادئ أوريجانس الأساسية: «النهاية ستجدد البداية، ومنتهى الأشياء سيرد إلى بدئها، وبذلك يستعاد الوضع القديم الذي نالته الطبيعة الناطقة، حين لم تكن بحاجة إلى الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. وكل شعور بالخبث سيبعد ويغسل فيصبح صافياً وطاهراً، والذي هو الله الصالح يصبح وحده كل شيء لتلك الخليقة الناطقة…، فعلينا إذاً أن نعتقد أن جوهرنا الجسدي كله سيرد إلى هذا الوضع، حين تعاد جميع الأشياء إلى الوحدة ويكون الله كل شيء في الجميع»[8]. وبالتالي فإن جهنم ليست أبدية، إذا إن الله سينتصر في النهاية على جميع أعدائه. فليس هناك عقاب، ما عدا العقاب الذي يداوي والذي من شأنه أن يمكن إصلاح المذنب وندامته. أدان المجمع القسطنطيني الثاني عام 553 أوريجانس وشجب المذهب الأوريجيني.
[1] هنري كريمونا، أوريجانس عبقري المسيحية الأولى، موسوعة المعرفة المسيحية، آباء الكنيسة، دار المشرق، بيروت، 1991، ص 7 – 13.
[2] الألفية هي المعتقد القائل بأن الأبرار القائمين من الموت، في نهاية الأزمنة، سيملكون في الأرض مع المسيح مدة ألف سنة. ويكون هذا الملك بين مجيء المسيح الثاني والقيامة من جهة، والقيامة العامة والدينونة الشاملة من جهة أخرى. عن دراسة في الإسكاتولوجيا، ص 26.
[3] في 1: 23. أنظر 1 -7- 5.
[4] 1كور 15: 28.
[5] الأب أوغسطين دوبره لاتور، دراسة في الإسكاتولوجيا، نقله إلى العربية الأب صبحي حموي اليسوعي، دراسات لاهوتية، دار المشرق، بيروت، طبعة أولى، 1994، ص 32- 35.
[6] في المبادئ، 1، 6، 10.
[7] هذه المخلوقات، بحسب أوريجانس، تستطيع أن تبتعد عن الله وأن تخطأ، حيث أنه بإمكانها أن تسقط من قمم الخير إلى أعماق الشر.
[8] في المبادئ،3، 6، 3.
* * *
ثانياً: المجيء الثاني والدينونة
نعلن في قانون الإيمان أن يسوع الذي مات وقام وصعد إلى السماء سوف يأتي من جديد ليدين الأحياء والأموات. هذا ما يدعوه التقليد الكنسي "المجيء الثاني"، بالنسبة إلى المجيء الأول أي إلى الزمن الذي قضاه يسوع على الأرض. ماذا يعني الإيمان بالمجيء الثاني ؟
لقد جاء المسيح أولاًَ مرسلاً من قبل الله، مخلصًا ومنقذًا العالم: »فلقد احب الله العالم حتى أنّه بذل ابنه الوحيد ، لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبديّة«[1]. والقديس بولس يؤكد: «إن الله قد برهن على محبته لنا بأن المسيح قد مات عنّا ونحن بعد خطأة . فكم بالأحرى وقد بررنا الآن بدمه، نخلص به من الغضب»[2]. المجيء الثاني هو ترقب ما سيصنعه الله للعالم في المستقبل على ضوء ما صنعه لأجله في الماضي. في مجيء يسوع الأول وفي كل أحداث حياته وموته أظهر لنا الله محبته ظهورًا خفيًّا وجزئيًّا في بقعة من الأرض وفي قلوب عدد يسير من المؤمنين. إيماننا بالمجيء الثاني هو الإيمان بأن تلك المحبة ستظهر ظهورًا علانيًّا نهائيًّا شاملاً. مجيء المسيح الثاني يعني لكل من يؤمن بيسوع، الانتصار على الموت، ورجاء حياة تكتمل فيها الحياة التي نقضيها على الأرض[3].
لكن المجيء الثاني هو أيضًا دينونة.
من سيدين الإنسان في المجيء الثاني ؟ وما هو مضمون هذه الدينونة ؟
يظهر لنا من خلال العهد الجديد أن الله الآب سيدين العالم[4] . (روما 2 / 3 – 13) (متى 6 / 4 ، 6 ، 15 ، 18) ، أو يسوع المسيح ( متى 25 / 31 – 33) (متى 13 / 40 – 42 ؛ 7 / 21 – 23) (1 كور 4/5) (2 كور 5/10). أو حتى الرسل والقديسون (متى 19/28) (1 كور 6/1-3). ولكن في إنجيل يوحنا تأخذ الدينونة طابعًا ذاتيًّا. فالإنسان هو الذي يدين نفسه برفضه كلمة المسيح: «إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلّص به العالم. فمن آمن به فلا يدان، ومن لا يؤمن به فقد دين، لأنّه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد». ثم يتابع إنجيل يوحنا معرفًا بمضمون الدينونة: «وعلى هذا تقوم الدينونة : أن النور جاء إلى العالم ، والناس آثروا الظلمة على النور ، لأن أعمالهم كانت شريرة . لأن من يفعل الشر يبغض النور ، ولا يقبل إلى البتة إلى النور لئلا تفضح أعماله . وأمّا من يعمل الحق فإنّه يقبل إلى النور ، لكي يثبت أن أعماله مصنوعة في الله»[5].
إن المسيح لم يأت للدينونة بل للخلاص. فمن يقبل كلامه ويؤمن به يخلص: إنّه منذ الآن في النور. وأمّا الذي يرفض كلامه ولا يؤمن به فقد دين. إن صيغة الماضي التي يستعملها يوحنا تعني أن الدينونة تبدأ منذ هذه الحياة بمجرد رفض الإيمان بالمسيح الذي نجد صوته في ضميرنا بالفطرة. فالإنسان إذًا هو الذي يدين نفسه بانفصاله عن المسيح وعن كلامه. وهكذا يتضح لنا أنّه لا تناقض بين إسناد عمل الدينونة إلى الله الآب أو إلى المسيح أو إلى الرسل والقديسين، أو إلى جميع المسيحيين، لأن الحقيقة هي التي في الواقع ستدين العالم. والحقيقة واحدة: إنّها حقيقة الله التي يحملها يسوع، كلمة الله، في كيانه وفي تعاليمه، والتي آمن بها الرسل والقديسون وجميع المسيحيين وعاشوا بموجبها. من هنا نستطيع أن نحدد الدينونة على أن الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته أولاً ثم لدى موته أخيرًا، يواجه الحقيقة التي تدعوه إلى التزام الخير. ودينونته تبدأ على هذه الأرض في موقفه تجاه الحقيقة التي هي الله نفسه، هذه الحقيقة التي ستدين العالم في نهاية الأزمنة قد أتت في الزمن لتخلص العالم، وقد أعطت ذاتها حتى الموت في سبيل هذا الخلاص. لذلك فإن الدينونة، هي أولاً عمل محبة وخلاص لأنّنا لا نستطيع الفصل بين مجيء المسيح الأول وموته وقيامته ومجيئه الثاني؛ إنها مراحل متعددة من سر واحد هو سر محبة الله التي تنسكب على الإنسان لتمنحه الحياة والفداء والخلاص. والدينونة ترافق كل مراحل هذا السر[6]. إن الإنسان، لدى موته، يواجه الحقيقة مواجهة صريحة لا مواربة فيها. عندئذ تنزع عن عينه الغشاوة التي كانت تفسد أمامه الرؤية، ويسقط من أمام وجهه القناع الذي كان مستترًا وراءه، فينكشف كما هو أمام الحقيقة، تلك ستكون دينونته. وهذا ما يصفه أحد اللاهوتيين المعاصرين بلغة وجوديّة فيقول: «إن مجرد انتصار الخير على الشر يكون الحكم الساحق على الذين يمارسون الشر. إنهم قد أخطأوا هدفهم. وحياتهم التي فقدت معناها، قد آلت إلى العدم. إن عبث حياة قضيت في الشر هو أسوأ عقاب … إن إدراك الإنسان ذاته قد سقط في أقصى العبث وغرق في العدم والتلاشي. ذاك هو مصير الذين يرفضون محبة الله ويرفضون دعوته إلى الحياة».
يرى معظم اللاهوتيين[7] اليوم أن المجيء الثاني سيتحقق لكل إنسان في ساعة موته، لأنّه إذ ذاك يلاقي المسيح. هذه النظريّة ممكنة ولكن شرط ألا ننسى أن المجيء الثاني لا يحقق فقط مصير كل إنسان، بل نعني أيضًا اكتمال تاريخ البشر في المسيح. ويمكننا أن نحل هذه الإشكاليّة أنّه بعد الموت نخرج من إطار الزمان والمكان، فكل زمن هو حاضر، وأنا بموتي معاصر لمجيء المسيح لكل البشر.
المجيء الثاني هو العمل الأخير الذي سيقوم به الله خاتمًا به سلسلة أعمال محبة بدأها بخلق العالم وتتالت عبر التاريخ وبلغت ذروتها في تجسده وفي حياته على الأرض وفي موته وقيامته. الله محبة، وقد ظهرت هذه المحبة في العالم والتاريخ، وستظهر ظهورًا نهائيًّا في كمال العالم والتاريخ. إيماننا بالمجيء الثاني هو يقيننا أن العالم لن يجد ملأه بقوّته الذاتيّة، والتاريخ لن يجد اكتماله بتطور شرائعه ونواميسه. فالعالم والتاريخ بحاجة إلى قوة تفوقهما وتمنحهما الملء والكمال[8].
[1] يو 3 / 16
[2] روما 5/8
[3] الأب سليم بسترس، اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر، سلسلة الفكر المسيحي بين الأمس واليوم، رقم 4، المطبعة البولسية، 1995، ص 332.
[4] المرجع السابق نفسه، ص336 – 340
[5] يوحنا 3 / 17 – 49
[6] مجلس أساقفة كنيسة ألمانية، المسيحية في عقائدها، نقله من الألمانية إلى العربية المطران كيرلس سليم بسترس، الفكر المسيحي بين الأمس واليوم، رقم 18، المطبعة البولسية، 1998، ص 318.
[7] المرجع السابق نفسه، ص 472.
[8]تيودول ري- مرميه، نؤمن، تعريب الخوري يوسف ضرغام، منشورات قسم الليتورجيا في جامعة الروح القدس، رقم 3، الكسليك – لبنان، 1983، ص 420- 421.
* * *
ثالثاً: السماء، جهنم والجحيم
قبل أن نتكلّم عن السماء وعن جهنم لا بد لنا أن نعرف ما كانت نظرة الشعب اليهودي للعالم، لأنّه بدون معرفتنا لهذه النظرة، لن نفهم بطريقة صحيحة مفهوم السماء وجهنم في الكتاب المقدس.
تصور الكون عند الشعب اليهودي: كان الشعب العبراني يميزون بين نوعين من السماء: السماء التي نراها ويطلق عليها بالعبريّة إسم الجلد، وهي طبقات الجو العليا، والكمة جلد تعني شيئًا صلبًا لأنهم كانوا يظنون أن القبة السماويّة هي طبقة صلبة زرقاء اللون. وعلى هذا الأساس كانوا يعتقدون أنها تحتاج إلى أعمدة ترفعها. لذلك ظنوا أن الجبال هي تلك الأعمدة التي تنتصب عليها القبة السماويّة. على سطح هذه القبة، تصوروا أن النجوم والكواكب مثبتة عليها، ففي تصورهم كان من الصعب أن تحتفظ هذه الأجرام بوضعها دون أن تكون مثبتة بطريقة ما في القبة السماويّة. وفوق القبة يمر نهر مياه، ومن فوق هذا النهر نجد السماء الثانية وفقها نجد الإله الذي يتحكم في كل الكون. فإذا أراد أن ينـزل المطر على الأرض، ما عليه إلا أن يفتح حاجزًا بين النهر والقبة فتنزل المياه من ثقوب موجودة فيها في هيئة قطرات المطر. أما الأرض فهي مؤسسة على الغمر وهو المياه الموجودة تحت سطح الأرض، لأن الأرض هي انحسار المياه عن اليابسة. وأما الجحيم، فهو مقر الأموات وهو موجود تحت الأرض، بمعنى أننا لو حفرنا حفرة كبيرة في الأرض سنجد الجحيم[1].
من هنا فإن كل تعابير السماء والمطهر والجحيم وجهنم مأخوذة بشكل أو بآخر من مفهوم العصر لهذه الحقائق. فالكتاب المقدس يعطي عدة صور للتعبير عن السماء: الحياة، النور، وليمة العرس، خمر الملكوت، بيت الآب، أورشليم السماويّة، الفردوس. وأن الله يجمع ذويه في ملكوته، وبعد أن يكون شعب الله قد أنهى مسيرته سيكون معه، محيطًا بعرشه ومسبحًا إيّاه للأبد: فتكون إذ ذاك أورشليم السماويّة ويكون نورها نور الحمل ولن تكون له نهاية. ويستعمل العهد الجديد أيضًا مثل هذه العبارات: "سنكون مع المسيح"، و"سنراه وجهًا لوجه"، و"سأعرف كما أنا معروف"، و"سنراه كما هو" إلخ[2].
يعرّف كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيّة السماء بقوله أن "الذين يموتون في نعمة الله وصداقته، وقد تطهروا كليًّا، يحيون على الدوام مع المسيح. إنّهم سيكونون على الدوام أمثاله، لأنّهم سيعاينونه "كما هو" (1 يو 3/2) "وجهًا لوجه" (1 كور 13/12)[3].
فالله بسبب سمّوه، لا تمكن رؤيته إلا متى كشف هو نفسه عن سرّه لمشاهدة الإنسان المباشرة ومكّنه منها. هذه المشاهدة لله في مجده السماوي تدعوها الكنيسة "الرؤية السعيدة" أو "الرؤية الطوباويّة". "سنراه كما هو" يعني أننا سنراه لا من خلال وسيط، ولا من خلال صورة ورسم وانعكاس، أي لا بشكل غير كامل، بل مباشرة.
يعترف المتصوفون بأن بعض القديسين يستطيعون الوصول، في هذه الحياة، إلى شيء من تلك الرؤية. ولكنها لا تكون إلا مؤقتة. من الواضح أن هذه الرؤية تتخطى على الإطلاق إمكانيات الطبيعة البشريّة. يستطيع الإنسان أن يرى جوهر الله أي الله "كما هو". ولكن هذه الرؤية ليست جامدة ونهائيّة، بل هي تزداد وضوحًا باستمرار. فإن "الراحة الأبديّة" لا تنفي حتمًا أن يكون هناك إعجاب يتجدد دائمًا أمام بهاء الله.
ولقد عبّر هنري بولاد اليسوعي عن هذا الموضوع في كتابه "الإنسان والكون والطور بين العلم والدين"[4] بقوله أن «هناك نظريتان للجواب على هذا السؤال: الأولى تقول إننا سنصل إلى ملء قامة المسيح وسنستقر في الحالة إلى للأبد. وأما الثانية، والتي أنا أكثر ميلاً إليها، فهي تفترض أننا سنعيش بعد القيامة في انطلاق ونمو وتجدد لا حدود لها . فالحياة حتى تكون كذلك لا يمكن أن تتوقّف، وهذا الجسد في نظري سينطلق من تجديد إلى تجديد إلى ما لا نهاية. كما يقول القديس غريغوريوس النيصي. بمعنى أن النهاية ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لأنني لا أستطيع أن أتصور الحياة في حالة سكون. يتصور بعضهم أن الأبديّة مجرد أن أشاهد الله فقط. كلا، الأبديّة كلها تجديد. يتصور بعضهم أننا في الأبديّة سنجلس أمام الله ونسبحه ونقدم له البخور إلى أبد الآبدين، وهو يستمتع بهذا المنظر، وأحيانًا ما نتصور الحياة الأبديّة على شكل مسرح كبير، والله على عرش في الوسط، والبشر يسجدون له وينمون بعض الترانيم. هذه الحياة مملة جدًّا، ولا أستطيع أن أتصوّر الأبديّة بهذه الصورة. لذلك أنا أحاول أن أجد حياة أبديّة فيها بعض التغيّر».
إن الكتاب المقدس يفرق بين الجحيم وجهنم . فالمسيح نـزل إلى الجحيم مقر الأموات، وأما الهالك فإنّه ينـزل إلى جهنم: إن هذين التعبيرين يشيران إلى فعلين متباينين، ويفترضان حالتين مختلفتين. إن أبواب الجحيم، حيث نـزل المسيح، قد انفتحت لتترك أسراها يذهبون في حال سبيلهم، بينما جهنم، حيث ينـزل الهالك، تنغلق عليه إلى الأبد. ومع ذلك فالتعبيران متقاربان، إذ أن الجحيم أسوة بجهنم هو مملكة الموت.
الجحيم :في إسرائيل القديم ، الجحيم أو الشيول (Shéol) هو مقر الأموات. كان الشعب العبراني يتصور أن بقاء الأموات في العالم الآخر أشبه بظل للوجود، عديم القيمة وبدون فرح. فالشيول أو الجحيم هو بالتالي الإطار الذي يجمع تلك الظلال. إنّه أشبه بقبر، فجوة، جب، حفرة (مزمور 30/10 حزقيال 28/8) في عمق أعماق الأرض (تثنية 32/22) حيث يخيم ظلام دامس (مزمور 88/16-17)، هناك ينـزل كل الأحياء ولن يصعدوا منها إلى الأبد. فليس بعد في مقدورهم أن يسبحوا الله أو أن يرجوا عدالته أو أمانته، إنّه التخلّي التام. في أي من نصوص الكتاب المقدّس ليس الجحيم رجاءً، لأن الأموات يعيشون فيه وجودًا ضعيفًا ومنعزلاً، لا يمكن تسميته "حياة". الجحيم هو مكان مخيف (إشعيا 14/9-11) ومكان النسيان (مزمور 88/13) والمكان الذي لا تصل إليه يد الله (مزمور 88/6)، والمكان الذي لا يحدث فيه بمعجزات الرب وبأمانته (مزمور 88/12)، والمكان الذي ينتهي إليه كل حي (جامعة 3/20) أن يكون المرء في الجحيم يعني أن يكون مفصولاً عن الله وعن جماعة الأحياء[5].
إن الرب يسوع عندما مات نـزل إلى مقر الأموات. فإن إثباتات العهد الجديد الكثيرة التي أوردت أن يسوع "قام من الموتى" تعني أنّه قبل القيامة أقام في مقر الأموات. هذا هو المعنى الأول الذي أعطته الكرازة الرسوليّة لانحدار يسوع إلى الجحيم: يسوع عرف الموت كسائر البشر والتحق بهم بنفسه في مقر الأموات. إلا أنّه انحدر مخلِّصًا معلنًا البشرى للنفوس التي كانت محتجزة فيه. إن الموجودين في الجحيم محرومون من رؤية الله: تلك هي حال جميع الأموات، في انتظار الفادي، سواء أكانوا أشرارًا أم أبرارًا. لم ينـزل المسيح إلى الجحيم لإنقاذ الهالكين بل لإعتاق الأبرار الذين سبقوا مجيئه. هذا هو المعنى الكتابي للجحيم. وباختصار نقول: أن عبارة نزول المسيح إلى مقر الأموات موروثة من العهد القديم، وهي تأكيد على حقيقة موت يسوع المسيح، وتعني أنّه اختبر الموت كسائر الناس. إن تساءلنا في أي مكان كان المسيح بين موته وقيامته، وكيف يجب تصور مثوى الأموات حيث أقامت نفسه، أثرنا مشكلة باطلة. يجب ألا نجهل مصطلحات اللغة الأسطوريّة المستعملة هنا للتعبير عن السر، وألا نفسر تفسيرًا ماديًّا وموضوعيًّا ما يجب أن نفهمه وفقًا لقواعد الرمزيّة حيث لا يعبّر تجانب الصور حتمًا عن تعاقب زمني ، بل يستخدم بالأحرى لتفصيل مختلف وجوه حقيقة معقّدة[6].
جهنم : لا نستطيع أن نتحد بالله ما لم نختر بحريّة أن نحبّه، ولكننا لا نستطيع أن نحب الله ونحن نرتكب خطايا ثقيلة ضد الله أو ضد قريبنا أو ضد أنفسنا. فالموت في الخطيئة المميتة دون التوبة ودون تقبل محبة الله الرحيمة، يعني البقاء منفصلاً عنه على الدوام باختيارنا الحر. وتلك الحالة من الإقصاء الذاتي عن الشركة مع الله مع الطوباويين هي ما يُدَلُّ عليه بلفظة "جهنم".[7]
فلنبدأ ببحث الموضوع من خلال نظرة الكتاب المقدس :
في مأساة "جنة عدن" كانت نتيجة معصية الإنسان ، أي نتيجة "خطيئة المبادئ" أن طرد الإنسان من هذه الجنة التي كانت تمثل الألفة مع الله: "فأخرج الرب الإله الإنسان من جنة عدن ليحرث الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبين وشعلة سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ". فالذي عصى، لأنّه أراد أن يجعل نفسه كالله، فقد الألفة مع الله." (تكوين 3/23-24). فطرد من الجنة ووضع خارجًا. فذكر جهنم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالخطيئة. وكذلك نراه في العهد الجديد أيضًا. والكتاب المقدس يصور جهنم بأنها النار التي تحرق دون أن تفني إلى ألبد. فنار جهنم لا دواء لها وهي نار الغضب الحقيقيّة، عندما تسقط الخاطئ القاسي القلب. ولكن هذه النار – وتلك هي قوة الرمز – إذا لم تعد باستطاعتها أن تزيل الدنس (كما في المطهر) فهي لا تزال تسبك خبث المعادن (حزقيال 22/18-22). ويعبّر الوحي هكذا عما قد يكون حال خليقة ترفض أن تطهر بالنار الإلهيّة وتظل مع ذلك خاضعة لحروقها. وهذا أخطر مما نقله إلينا التقليد عن إبادة سادوم وعامورة (تكوين 19/24). ولعل الناس قد ارتكزوا على طقوس وادي إبن هنوم، المفعمة بالنجاسة (لاويين 18/12 ، 2 ملوك 16/3 ؛ 21/6 ؛ إرميا 7/31 ؛ 19/5-6) وتعمقوا في الصور النبويّة للحريق (إشعيا 29/6 ؛ 30/27-33 ؛ 31/9) وصهر المعادن، فذهبوا إلى تمثيل جهنم بالنار (إشعيا 66/15-16). وإن جثث الناس الذين عصوا الله "دودها لا يموت ونارها لا تطفأ" (إشعيا 66/24 ، مرقس 9/48). فيجعل الله لحومهم للنار والدود (يهوديت 16/21).
وفي العهد الجديد، فإن يسوع، مع رفضه أن يقوم بدور الديّان، فقد أبقى سامعيه في ترقب نار الدينونة، مرددًا الكلام المألوف في العهد القديم. فهو يتكلم عن نار جهنم (متى 5/22) هذه النار التي تحرق الزؤان الذي يعطل الأرض (متى 13/40)، والأغصان التي تنفصل عن الكرمة (يوحنا 15-6) فجهنم نار لا تطفأ (مرقس 9/43-44)، بل هي أتون النار (متى 13/42،50). إحتفظ المسيحيّون الأولون بهذا الكلام مع تكييفه وتطبيقه على مختلف الحالات. فبولس الرسول يستخدمه في وصفه لآخر الأزمنة (2 تسالونيكي 1/8) وتظهر الرسالة إلى العبرانيين ما سيكون من مظهر النار المريع، التي ستلتهم العصاة المتمردين (عبرانيين 10/27)[8].
أما كل هذه التصاوير من العهد القديم والعهد الجديد نعي أننا نواجه مشكلة وهي حجر عثرة للفكر المسيحي المعاصر. فمن جهة أولى يشق على متطلباتنا النقديّة أن نقبل بتلك الصور التي تصدم عقليتنا والتي تغذى بها سلفنا: صورة العذابات المفروضة على الهالكين، أو صورة تلك النار التي تحرق من دون أن تفني، وأن هذه النار وهذه العذابات ستبقى إلى الأبد. وكان الوعّاظ يجدون لذة في إقامة الدليل على أن خطيئة مميتة واحدة تستوجب تلك العقوبات الفظيعة، وهذا ما ترك في أجيال وأجيال آثار الهواجس النفسيّة. والنتيجة كانت أن موضوع جهنم صار من المواضيع المحرّمة، لا يجرؤ الناس على تناوله، أو أصبح موضوعًا مهملاً تمامًا في بعض كتب التعليم المسيحي الحديثة. ومن جهة أخرى، فهناك اعتراض أكثر أهميّة: وهو أنّه إذا كان الله محبة، كما علمنا العهد الجديد، فلا بد أن تكون جهنم مستحيلة. أو إذا كان الله رؤوفًا إلى أقصى درجة، فأحب العالم حتى إنّه أرسل ابنه ليخلصنا، كيف يستطيع هذا الإله نفسه أن يحكم بالهلاك الأبدي على مخلوقاته التي يحبها[9] ؟
إن المشكلة إذا طرحت على هذا الشكل، لا حل لها. فمن جهة يجب أن ننطلق من المفهوم الرمزي للصور المعتمدة في الأدب الرؤيوي في الكتاب المقدس. ومن جهة أخرى يمكننا القول بأنه إذا كانت جهنم حجر عثرة فإن هذه العثرة لا تأتي من الله، بل من الإنسان الذي يرفض الله ومحبته. ليست جهنم سر الله بل سر الإنسان، أو بالأحرى سر الشر. حتى إنّه يمكننا أن نتساءل هل الخطيئة وجهنم ليسا هما حقيقتين متطابقتين: فتكون الخطيئة صورة سابقة لجهنم وتكون جهنم الكشف التام عن تلك الحقيقة التي هي الخطيئة ؟ فوجود جهنم أبديّة هو حجر عثرة لا في نظر غير المؤمنين فقط بل في نظر الشعور المسيحي أيضًا. لقد تمنى بولس نفسه أن يكون ملعونًا في سبيل إخوته اليهود الذين لم يقبلوا رسالة الإنجيل[10]. ولم ينفرد بولس _ والكثير من القديسين بعده _ بالشعور بعثار الانفصال عن المسيح. فالمسيح نفسه شعر بالنفور من تلك الخطيئة التي تؤدي إلى الموت، حتى إنّه رضي بأن يكون ضحية أمير الظلمات، لمغفرة الخطايا. هو نفسه جعل من نفسه "خطيئة" من أجلنا. "ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا كيما نصير فيه بر الله "[11]. ولذلك شعر المسيح، وهو على الصليب، بأن أباه تركه[12]. هناك تيار لاهوتي في أيامنا يلفت النظر إلى اختبار "الترك" من قبل الله، الذي شعر به المسيح وهو على الصليب: " صار لعنة لأجلنا"[13]. لم يمت فقط ، بل عرف "جوهر الموت الثاني"، وهو الموت الأبدي: "ما هو ملعون ومنبوذ نهائيًّا بعيدًا عن الله في الدينونة يسقط حيث يجب أن يسقط". فإن هذا حجر عثرة أيضًا بحسب حكمة هذا العالم " إننا نبشر بمسيح مصلوب، عثارًا لليهود وحماقة للوثنيين ".
فجهنم إذًا هي اللامعقوليّة بالذات، والمأساويّة المطلقة. إنها عنف تستطيع الحريّة أن تفرضه على نفسها، عنف يخالف الطبيع، لا يريده الله ولن يريده أبدًا. ومن هنا توصف جهنم اللامعقولة في الإنجيل بمظهر الممكن الذي قد ينعت بالممقوت والذي لا يبدو متسبعدًا تمامًا.
ليس إذًا عثار جهنم في الله، بل في الذي رفض محبة الله وسار خلافًا لطبيعته، لأنّك "جعلتنا لك يا رب، ولا يجد قلبنا الراحة حتى يرتاح فيك" (القديس أغوسطينوس) . فإن الله في المسيح لم يهمل شيئًا ليحفظنا. إن نصوص العهد الجديد في موضوع جهنم ليست تهديدًا بل تحذيرًا. فالتصريح بعمق الأشياء حين يُنبَذ المسيح للأبد بسبب رفض الإنسان، ليس هو إعلانًا عن حتميّة، بل تنبيه القلوب إلى جدّية الملكوت. وإذا كلمنا المسيح في الإنجيل على هلاك ممكن للإنسان بسبب رفض المحبة، فلا يعني ذلك أن هذا الهلاك أمر واقع، بل لكي يبعد عنه.
وبالتالي، فمن خلال هذا السر اللامعقول، سر جهنم، كما عرضناه، يظهر الله، على وجه أفضل، ما هو، أي محبّة للبشر. فإن هذه المحبّة، التي تبذل نفسها، تحترم شريكها وحريته، لا بل رفضه، مهما كان غير معقول، بسبب الجديّة والاحترام اللذين تعتبر بهما البشر. فإن محبة الله لا وجود لها كمحبة إلا نحو حريّة لا يستطيع الله أبدًا أن يحل محلها أو يلاشيها. فليس بإمكان الله أن يتغلب على حريّة انغلقت على نفسها، حتى إنها كلما ظهرت المحبة المبذولة لامتناهية، أراد الرفض لها أن يكون تامًا. وحتى إن رفضت هذه المحبة فإن الله المحبة يبقى مقدَّمًا ومُحِبًّا، إذ لا يمكن أن يكف الله عن أن يكون محبة "لا يمكنه أن ينكر ذاته".
[1] الأب أوغسطين دوبره لاتور، المرجع السابق، ص 48.
[2] تيودول ري- مرميه ، المرجع السابق، ص 456 – 458.
[3] التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، ف 1023.
[4] الأب هنري بولاد اليسوغي، الإنسان والكون والطور بين العلم والدين، دار المشرق بيروت، ص 308-309.
[5] الأب أوغسطين دوبره لاتور، المرجع السابق، ص 106.
[6] الأب سليم بسترس، المرجع السابق، ص 347.
[7] التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكيّة عدد 1033
[8] الأب سليم بسترس، المرجع السابق، ص 349.
[9] تيودول ري- مرميه ، المرجع السابق، ص 458.
[10] روما 9/2-5
[11] 2 كور 5-21
[12] مرقس 15-34
[13] غلاطية 3-13
رابعاً: المطهر
لا نصادف تعبير "المطهر" في الكتاب المقدّس، فهو تعبير لاتيني (purgatorium) إستعمله التقليد الكنسي منذ القرن الحادي عشر، للإشارة إلى مكان أو حالة متعلقة بالعالم الآخر، اعتبرت هذه الحالة كحالة وسطى بين السماء والجحيم، وهي حالة مؤقتة، فيها يوجد الأموات غير المقدّسين بالكامل، وغير المطبوعين جذريًّا بالخطيئة. فلذلك وجب عليهم أن يتطهروا قبل دخولهم في شراكة كاملة مع الله، وقبل استعدادهم للقيامة العامة أو النهائيّة[1].
الأسس الكتابيّة :ليس من السهل إيجاد شهادة كتابيّة واضحة لعقيدة المطهر الكنسيّة. فالعهد القديم لا يتكلم بوضوح عن مطهر، وإن كنا نجد في بعض النصوص اليهوديّة غير الكتابيّة المتأخّرة (القرن الأول بعد المسيح)، تلميحًا إلى إقامة مؤقتة في الجحيم لبعض الخطأة غير الكفّار. لكنّه يمكننا إيجاد إطار غير مباشر للكلام عن ضرورة تطهير ما بعد الموت، خصوصًا إذا استندنا على الربط الذي يقيمه الأنبياء بين الدينونة والتطهير: ليست غاية الدينونة الملاشاة أو العذاب بلا نهاية، بل التطهير والخلاص النهائي. ويمكننا أن نستند على نص 2 مكابيين 12/42-45، الذي يتكلّم عن الصلاة لأجل الموتى لنجد فيها إطارًا لمفهوم التطهير بعد الموت. هذا النص يتكلم عن ذبيحة يهوذا المكابي وجماعته عن اليهود الذين سقطوا في الحرب مع أنطيوخوس الرابع إبيفانوس الذي دنس الهيكل.
في نفس خط العهد القديم، يتحفظ العهد الجديد أيضًا حول مسألة مصير الأموات، ولا يكثر من الصور والأفكار حول ذلك لكنه يعلن أن الموت لا يلاشي الكائنات البشريّة التي يمسها فهناك استمراريّة للحياة بعد الموت أي أنّ هناك حياة أخرى. فالأموات الذين يشتركون في المسيح تعطى لهم نعمة المشاركة في قيامته ومن ناحية أخرى يشدد العهد الجديد على غاية ونهاية هذا الرجاء أي على ما نسميه القيامة الأخيرة لا على الفترة المتوسطة التي تمتد بين كل موت واليوم الأخير أو الدينونة العامة. لدينا نصان من العهد الجديد يدعمان هذه الفكرة. 1 تس 4/14 "فأمّا ونحن نؤمن بأن يسوع قد مات ثم قام فكذلك سينقل الله بيسوع ومعه أولئك الذي ماتوا " . و1 تس 5/10 : " بيسوع المسيح الذي مات من أجلنا لنحيا معه متحدين به ، أساهرين كنا أم نائمين". يعتبر بولس الأموات نائمين ومدعوين إلى الإتحاد بالقائم. وهذا يدل على الإيمان بالقيامة أكثر منه على مصير الأموات الحالي. أمّا التقليد الكنسي فقد استند إبتداءً من أوريجانوس في تبريره ضرورة التطهير للمؤمنين على 1 كور 3/12-15: سيخلصون ولكن كمن يخلص من خلال النار". إلا أن التفسير المعاصر لهذا النص يظهر أن بولس لا يقصد الإشارة إلى حدث محدد أو مكان بعد الموت بل إلى صعوبة الخلاص كما يلمح مزمور 16/12 إلى النار المطهرة "خضنا النار والماء ثم أخرجتنا فانتعشنا". ومتى 12/32 "من قال كلمة في الروح القدس فلن يغفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة" . دليل على إمكانيّة المغفرة في الآخرة[2] .
النار المطهرة في تعليم المعاودة: يشير تعبير "معاودة"Apocatastase إلى الإصلاح، إلى إعادة التركيب والعودة إلى الأصل. نصادف هذا التعبير بتواتر عند الآباء الرسوليين والمدافعين، بمعنى العودة إلى وضع سابق سواء في الاكتمال وتحقيق وضع أفضل، أو في الفداء وتأسيس البشريّة من جديد في المسيح (يوستينوس، إيريناوس). ويعتبر أكليمنضوس الإسكندري المعاودة إمكانية تطهير النفوس بعد الموت. فطريق النفس نحو معرفة الله، الذي يتخطى هذا العالم، هو تطهير فقط. عندما تجتاز النفس هذا الطريق، يمكننا الكلام عن إكتمال الإنسان. من جهة أخرى، يطرح تعليم إكليمنضوس هذا عن المطهر مسألة خلاص جميع البشر الممكن. لأنّه يبدو أن لعقوبات بعد الموت دورًا مطهِّرًا أكثر منه عقابيًّا نهائيًّا. لذلك يمكننا اعتبار إكليمنضوس الشاهد الأول على تعليم التطهير ما بعد الموت[3].
لكن تعليم المعاودة ارتبط باسم أوريجانوس الإسكندري، الذي تطرقت إليه سابقاً، وذلك بسبب التأثير الكبير الذي مارسه على اللاهوت الشرقي، وبسبب إدانته من قبل الكنيسة. تعني المعاودة عند أوريجانوس إعادة وحدة العالم الأصليّة، أي اكتمال التاريخ النهائي بقوة الله، الذي يوجِد ويعيد التناغم بين الإرادة والكيان. إنطلاقًا من 1 كور 15 / 28 "ليصبح الله كل شيء في كل شيء"، يتصور أوريجانوس الطريق الذي يقود غلى ذلك : في خضوع كل شيء للابن وخضوع الابن للآب. في عمليّة الخضوع هذه، يلعب المسيح دور المعلم والشافي: إنّه يعلّم كل الراغبين في التقدم بالقوة الخلاصيّة الساكنة فيه؛ كما أنّه يشفي النفوس من عاهاتها. هذا يعني أن لكل عقوبات ما بعد الموت دورًا تربويًّا وشافيًا: إنّها تؤهل الإنسان ليصبح بحريّة ما يطمح إليه في طبيعته. يفسر أوريجانوس النار المطهرة على أنها الأثر الذي تتركه الخطيئة فينا، والتأنيب الذي يشعر فيه الخاطئ بسببها .
كما تصور أوريجانوس فكرة "عماد النار" تطهيرًا إسكاتولوجيًّا ، إنطلاقًا من تفسير لـ 1كور 3 / 11-15 : الله نفسه هو النار التي تطهر . من خلال هذا الامتحان يثبت ما عمله كل واحد من مواد غير فاسدة ذهب أو فضّة ويحترق ما عمله من مواد قابلة للاحتراق، قش أو خشب. يشاهد البار المخلَّص والمطهَّر أعمال الله، والله نفسه، ويتحد فيه بالحب. مع ذلك، تبقى فترة تطهير الأموات غير محددة. من الواضح أن الآباء تصوروا هذه الفترة لاحقة للدينونة الأخيرة .
التطهير في اللاهوت الشرقي: على عكس ما كان يجري في الغرب، أدّت المجادلات التي نشأت في الشرق، حول تعاليم أوريجانوس، إلى اعتبار كل فكرة حول التطهير ما بعد الموت ، عودة إلى تعليم المعاودة، المحروم في مجمع القسطنطينيّة الثاني (553). وبالتالي رفضت غالبيّة آباء الكنيسة اليونان تعليم التطهير بعد الموت.
وخلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ومن بعد القطيعة مع الشرق (1054)، حاولت الكنيسة اللاتينيّة تحديد حالة النفس في طور التطهير. ويبدو أن عبارة "مطهر" Purgatoire قد ظهرت لأول مرة حوالى سنة 1170، للإشارة إلى مكان مميز، فيه توجد "أنفس المطهر". وقد عرف هذا التعبير إنتشارًا واسعًا وتطويرًا في اللاهوت المدرسي، في فترته الذهبيّة. فمن جهتها رفضت الكنائس الشرقيّة فكرة المطهر الغربيّة، أمانة للكتاب المقدّس واحترامًا للسر (mystère)، ولكن هذه الكنائس تمارس الصلاة التقليديّة لأجل الموتى، وتتحدّث غالبًا عن ألم الضمير عند ذاك غير المتطّهر بعد، لكنّها ترفض كل فكرة عن مكان أو عن نار مطهّرة وتفضّل ترك أمر حقيقة النار الأبديّة إلى الدينونة الأخيرة[4].
خلاصة لاهوتيّة :تطرح العقيدة المسيحيّة المتعلّقة بالمطهر مسألة تفسير خاصة حول العلاقة بين التأكيدات الإيمانيّة والتصاوير. لقد وجدت هذه العقيدة نفسها مضطرة إلى استعمال صور ورموز لتتكلم عن اختبار يتم خارج حدود هذه الحياة ، ويتعلّق بالحياة بالله . فكانت صور النار والمكان والزمان للكلام على التطهير الضروري قبل دخول السعادة الأبديّة . هذا ما قاد اللاهوت إلى الوقوع أحيانًا في بعض التفاسير الشيئيّة لهذه الصور والتصاوير . فغلب الاهتمام بتقديم وصف إخباري لنهاية الأزمنة على حساب واقع الحياة المسيحيّة . لكن اللاهوت المسيحي المعاصر صحح هذه التصاوير الشيئيّة والمكانيّة في تعليم المطهر ، وأحلّ محلها مفاهيم شخصيّة : من هنا يجب أولاً فهم النار بمعنى مجازي كما لا يجب تصور المطهر كمكان بل كحدث يتحقق في الإنسان ذاته. من هنا يجب التخلي عن فكرة النار والزمان والمكان ، والتمسك فقط بتصور التطهير الأساسي: ضرورة تطهير الإنسان في سبيل رؤية الله[5].
وأمّا نار المطهر التي تحرق هي قبل كل شيء نار المحبّة الإلهيّة التي تلهب كل نفس يقترب منها . يتكلم يوحنا الصليب في كتابه "الليل المظلم" عن "ليل الحواس" الذي تعي فيه النفس حقيقة شقائها الذي كانت تجهله، فتعاني النفس الجفاف والترك من قبل الله . وفي هذه الحالة "ينير الله النفس" فتعرف شقاءها وضِعتها وتكتشف عظمة إلهها وسموّه ، وبذلك تتحرر النفس من ظواهر الإعجاب بالنفس. ربما يمكننا تطبيق كلام يوحنا الصليب على مفهوم المطهر . ويضيف يوحنا الصليب أن النفس رغم عذابها فهي تشعر بفرح محبة الله. وفي النهاية فإن سبب عذاب النفوس في المطهر هو اقترابها من نار المحبة الإلهيّة[6].
ومن ناحية أخرى فإن المطهر هو ألم في سبيل الاكتمال . ففي لقائه مع المسيح الديان والمليء بالحب في الوقت نفسه ، تنحل ترسبات الخطيئة في الإنسان ، وتتلاشى بقايا الأنانيّة . من هنا يجب تصور المطهر على أنّه ألم في سبيل الاكتمال ، ألمًا مطوبًا ، لأنّه يحرر ويكمل ، ألما مؤلمًا لأنّه يزيل بقايا الخطيئة التي أصبحت جزءًا من "الأنا" . ليس المطهر إذًا حدثًا محدّدًا يضاف إلى حدث الدينونة ، بل هو وقت من أوقاتها ، كما أن الدينونة هي دينونة ذاتيّة ، فيها يتحمّل الإنسان نتائج خياراته الأساسيّة في حياته . فالإنسان الذي لم يتمم نهائيًّا نموه على الأرض يكمّله في مرحلة ما بعد الموت ، لكي يصل إلى انفتاح كامل على الحب ، لأن ملكوت السماوات هو حب كامل . إذًا من لم يستطع أو من لم يحقق على الأرض قبل موته هذا الحب الكامل ، والأرجح أنه لم يستطع أي إنسان تحقيق ذلك ، يواصل بعد الموت تحقيقه .
الخاتمة
إن خاتمة هذا الدرس لا تنتهي بفكرة جهنم ، بل تنتهي بفكرة محبة الله ، تلك المحبة التي هي كناية عن مسلسل بدأت أولى حلقاته عند خلق الإنسان ، والحلقة الأخيرة تكون في القيامة العامة حين يصير المسيح "كل شيء في كل شيء" . وهذه لنهاية سعيدة ، لا بل إنها أسعد نهاية يمكن أن يتصورها إنسان . إذا كان هذا الدرس قد بعث الرهبة في النفوس ، فإنه إعلان بأنه فشل في مهمته . وإذا كان بعث الرجاء في القلوب وأظهر جليًّا محبة الله العظمى للإنسان ، وهذا الرجاء دفعه إلى الإلتزام بطريق المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة ، لا خوفًا من دينونة بل تعمقًا وتجذرًا في المحبة ، يكون وصل إلى غايته المطلوبة .
[1] الأب أوغسطين دوبره لاتور، المرجع السابق، ص115.
[2] المرجع السابق، ص 117.
[3] معجم الإيمان المسيحيّ، اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر الأب صبحي الحموي اليسوعيّ، أعاد النظر فيه من الناحية اللاهوتيّة الأب جان كوربون، بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، دار المشرق، بيروت، 1998، ص 470.
[4] تيودول ري- مرميه ، المرجع السابق، ص 464.
[5] المرجع السابق نفسه.
[6] مجلس أساقفة كنيسة ألمانية ،المرجع السابق، ص 478.