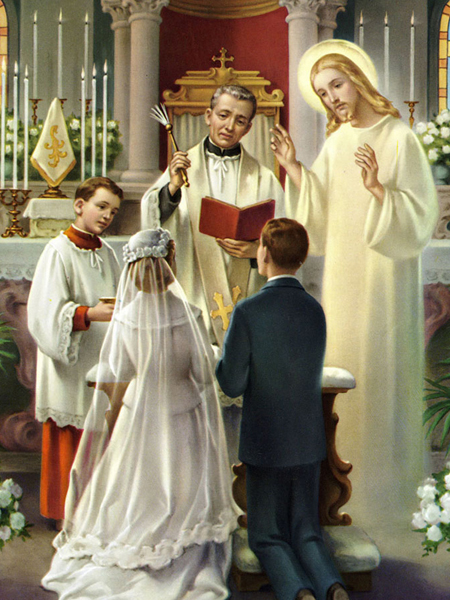الإكليريكية فإنه يلمس بطريقة فعالة أيضاً الكثير من عناصر حياة وإيمان كنيسة اليوم. هذا لا ينفي بالطبع ظهور بعض النقد العنيف للكاتب والكتاب بالذات حول ما أثاره عن التكوين في المعاهد الإكليريكية لكن المحصلة النهائية هي أن كل ما أثير حول هذا الكتاب سلباً أو إيجاباً يعتبر في صالح الموضوع ومن صميم اهتمام الكاتب. وليس الهدف من هذه السطور هو الدخول في الجدل الدائر بل بالأحرى إقامة حوار بنّاء حول المواضيع المطروحة عن طريق عرض محايد لوجهة نظر الكاتب.
يرتكز الكتاب إلى محورين:
أولاً: وضع “التعليم الإيماني” في المعاهد الإكليريكية
ثانياً: وضع العلاقة “كاهن- علماني” كما تُعاش في المعاهد
أولاً: التعليم الإيماني
يركز موضوع الجزء الأول من الكتاب على وصف العناصر والنتائج الهدامة لنظريات حديثة تهدف إلى قصر “أسرار الإيمان” على مسائل وتفسيرات أنثروبولوجية بحته… مما يشكل تهديداً حقيقياً يجب أن يتخذ المسؤولين في المعاهد اللاهوتية خطوات فعالة لدفعه وإن كان الأمر أصعب من أن يواجهه فرد بالذات ولعل الكاتب هنا يضع علامة استفهام حول صحة تعليم بعض المكونين أو الأساتذة.
إن أهم الأركان التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في تناولنا لموضوع “التعليم الإيماني” في المعاهد الإكليريكية وكليات اللاهوت هي “أهمية التقليد الكنسي” فليس من الممكن الدخول لنور فهم المعطيات الإلهية الموحاه دون قبولها من هذا المنطلق. إذ ليس مقبولاً ولا معقولاً أن يقيم أحد من نفسه حكماً على إيمان الكنيسة كما لا يمكن لمسيحي حقيقي أن يختار من محتويات “التعليم الإيماني” ما يتفق مع أفكاره ومعتقداته الشخصية وحساسياته فحسب وأن يترك ويهمل ما لا يروقه منها.
لذلك فمجمل “التعليم الإيماني” ومعطيات الوحي الإلهي يجب أن تُطرح في إطار تناسق السياق الداخلي لهذا الإيمان، بلا تنازلات وبدون “سرانية” أي إحاطة المواضيع العسيرة الفهم بالغموض والإبهام حتى لتبدو وكأنها غير مقبولة من تلك الاتجاهات النظرية.
والتمسك بهذا “التعليم الإيماني” بطريقة جامدة، لم يعد أمراً سهلاً إذ لا يكفي أن نردده ونكرره كصيغ ثابتة لا تقبل حتى الشرح والتأويل… فقد وصلت إلينا هذه التعاليم عبر السنين واجتازت الهرطقات وعشرات القرون الطويلة لتبلغنا رسالة حيّة ألا وهي أن الله نفسه هو الذي يمنح “هبة الإيمان” وأنه يفعل ذلك في الكنيسة وعن طريقها. ولا يمكن الابتعاد عن هذا السياق دون أن نعرض أنفسنا لخطر الانفصال عن “نبع الحياة” يجب إذن أن نحاول صياغة إيماننا اليوم في إطار ثقافتنا الحديثة وإلا ظل هذا الإيمان منحصراً في كلمات جافة بلا معنى حياتي حيث لا حياة للإيمان دون أن نوصله للآخرين بمعنى أن نقدمه لمعاصرينا وأن نقنعهم به وأن نجعلهم يحبونه. لذلك فلا مفر من قبول الحوار والدخول في المناقشة والمواجهة بل والمعارك الأليمة حتى نصل عبر ذلك كله إلى القناعة بأن الذكاء والعقل البشري يجب أن يخضعا للنور الإلهي وأن يسعيا في تواضع ليتخلل هذا النور حناياهما وكيانهما، ويتم ذلك من خلال عملية الانثقاف التي تقبل هذا السياق وترفضه في وقت واحد.
يبدأ هذا الصراع أساساً داخل كل فرد على حدة لأننا، والحمد لله نشكل جزءاً من هذا العالم، ولا نتوقف مطلقاً عن محاولة الوصول إلى فهم أفضل لإيماننا. ولا يستغرب هذا الصراع الداخلي الداخلي إلا من لم يواجه نفسه يوماً بسؤال أو من لم يلاقِ مقاومة داخلية ولم يتطرق إليه الشك يوماً أمام أي من عناصر الإيمان… تلك العناصر التي تمثل جزءاً أساسياً من الحرب الروحية اليومية لأي مسيحي حقيقي.
من هذا المنطلق يكون من الخطأ البديهي أن نستثني طالب اللاهوت من هذا الصراع، فهو، مثله مثل أي مسيحي، غير قادر على الوصول لنور الإيمان، دون أن يمر بتلك المرحلة العصيبة ويتجاوزها. ومواجهة هذه التساؤلات تكوّن وتنمّي لديه القدرة على مواجهتها. فالاعتراضات المنطقية والتعبير عن نقاط الشك والغموض وإتاحة الوقت لعملية الانثقاف الإيماني… كل هذا يؤهل الطالب لإقامة علاقة حوار بنّاء مع معطيات “التعليم الإيماني”.
ويُعتبر هذا مطلب من مطالب المربين والمعلمين في المعاهد والكليات اللاهوتية ذلك أن التكوين الحقيقي هو الذي يتيح الفرصة والوقت أمام الطالب ليبدأ، مبكراً، في إقامة هذا الحوار بطريقة هادئة متزنة وفي ظروف بيئية ملائمة وتحت متابعة من أساتذة ومعلمين ومرشدين قادرين أن يوجهوا مسيرته ويقودوا خطاه في مسيرة نحو الوصول إلى فهم واقعي وواع لمعطيات “التعليم الإيماني” في إطار الكنيسة بطريقة شخصية مسؤولة. ومن المهم أخيراً أن تدعم هذا الحوار اللاهوت الداخلي ويسنده شجاعة رسولية؛ فعبر حوار من هذا النوع يخرج الطالب منتصراً قوياً في إيمانه، منفتحاً في تفكيره، مطيعاً وخاضعاً بوعي لتعاليم الكنيسة. حيث أن عدم الثقة بالنفس والخوف من فقدان الهوية مؤشران سلبيان يثيران المقاومة الداخلية والقلق. فالخوف من فقدان الهوية في مناقشة مفتوحة مع الآخرين يولّد انغلاقاً على الذات وتصلباً في الرأي، فتتحول عملية إعلان الإيمان حينئذ إلى محاولة لإثبات الذات والتشبث بالرأي والدفاع عن الوجود والهوية والكيان، بدلاً من أن تكون عرض وطرح لموضوع قادر أن يصل ببساطة ووضوح إلى الآخر حيث هو في الزمان والمكان.
والسؤال الآن: ألعل انطباعات الكثير من طلبة اللاهوت عن درسيهم تبرهن أن هؤلاء مشغولون أساساً بتلك النظريات التي يحاول الأب مانارنش تنبيهنا لخطورتها على الإيمان؟ أم لعل تلك الانطباعات عينها تثبت أن الكثير من هؤلاء الطلبة يحاولون تفسير التعليم المقدم إليهم عبر شكوكهم ومخاوفهم الشخصية مما يحوله إلى تعليم مشوه لا يعبر عن معطيات “التعليم الإيماني” للكنيسة؟
لكي نكون محايدين يجب طرح السؤال بطريقة أخرى لأن هناك حقيقة ثابتة وهي أنه حين يبدأ المرء التفكير والبحث عن إيمانه عبر الشكوك والمخاوف أولاً أي عبر كل ما يهدد هذا الإيمان، فلن يصل أبداً إلى أن يرى هذا الإيمان كعرض حر جذاب مازال حتى اليوم قادر على الجذب والإقناع.
ثانياً: العلاقة بين الكهنة والعلمانيين في الكنيسة
موضوع العلاقة بين الكاهن والعلماني موضوع آخر نود أن نعبر عن بعض تحفظاتنا عليه. فبعدما طرحنا التساؤل حول هوية الإيمان يُلقي الكاتب الضوء حول هوية الخدمة ففي إطار عودة العلمانيين إلى تولي مسؤولياتهم في حياة الكنيسة برزت بعض الصعوبات في العلاقة كاهن-علماني، وقبل أن نبدأ في مناقشة هذه الصعوبات نود أن نؤكد على أهمية ما شهدته هذه العلاقة من تطور كبير في الحقبة الأخيرة. لكن النقص المتزايد في عدد الكهنة لا يسهل إتمام مسيرة التطور لهذه العلاقة بطريقة هادئة مما يدفع إلى حلول سريعة لا يُتاح الوقت فيها للنضوج الفكري وبالذات في مجال التربية والتكوين.
ولا يدهشنا إذن أن نلاحظ وجود العديد من الأخطاء والتجاوزات مما يُزيد في تعقيد المواقف. كما يحتاج بعض العلمانيين إلى فهم وقبول متزايد للمعنى “السري” للخدمة الكهنوتية. وهذا يجب أن يشكل جزءاً هاماً من التربية الإيمانية المقدمة للشعب المسيحي. كما أن وجود بعض المتشددين في السلك الكهنوتي والذين يطالبون بسلطة كهنوتية مطلقة لا يدهش سوى الناس غير الملمين بالضعف البشري. لكن من الجهة الأخرى كم من العلمانيين المخلصين بذل ومازال يبذل من جهده وطاقته ووقته حتى تستمر مسيرة الكنيسة حيث يوجدون، وفي تكامل وتعاون وثقة كاملة مع الكهنة والمرسلين.
إن المكانة المتزايدة الأهمية التي يحتلها العلمانيون في كنيسة اليوم تدفع الكهنة بالتالي لأن يعيدوا التفكير في أبعاد دورهم. فحيث يبدأ أعضاء هيئة ما في ترتيب أوضاع وأوراق علاقاتهم المتبادلة، ينجم عن ذلك حتماً، بعض الاهتزاز في إدراك كل منهم لهوية وماهية دوره. يحتاج الأمر حينئذ إلى نوع من الصبر والقدرة على التمييز والرغبة في التوصل سوياً إلى أسس مشتركة وذلك عن طريق استكشاف متدرج للأوضاع والهموم المشتركة عبر مواجهة صريحة كل لمسئولياته نحو الرسالة الموكلة كل واحد حسب موقعه.
وهنا أيضاً فإن الاهتزاز وعدم الثقة بالنفس أمر سيء للغاية يقود إلى اتخاذ أوضاع متصلبة ويحمل إلى التشبث بسلطان لا ينتوي الطرف الآخر الاعتراف به. مما يمنع في النهاية من التوصل إلى طريق مشترك في الكينونة معاً والسلوك المشترك في احترام للأدوار التي يقررها الإيمان المشترك لكل من الطرفين.
لا يجب التسرع بالحكم على كل موضوع خلاف بأنه خطر يهدد العقيدة وهذا لا ينفي حقيقة أن بعض الجماعات المسيحية في مسيس الحاجة اليوم إلى التعمق في معاني “هوية الخدمة الكهنوتية” ولن يتم ذلك باتخاذ أوضاع متسلطة متصلبة بل بالأحرى بالحياة في التواضع وروح الخدمة الكهنوتية والمسيحية اللتان تشكلان قلب ولب الخدمة الكهنوتية.
وعندما يشعر العلمانيون بالحب والاحترام من منطلق كونهم كذلك فإنهم يقبلون أن يدخلوا في محاولة اكتشاف ما هو “سري” في الكهنوت (بمعنى أسرار الإيمان) لدى من يمثلون بينهم حضور المسيح- الراعي.
تكمن المشكلة في أن بعض الصعوبات تبدو من أول وهلة قاسية وعنيفة، وأن المطلوب من الكهنة وبالذات “الكهنة الشباب” هو أكبر من طاقاتهم. وهذا حقيقي لكنه يشكّل لهم في نفس الوقت دافع كي يندمجوا في الخدمة الرسولية بحرية روحية مؤسسة على بنيان روحي داخلي.
ولا يمكن ألا يرافق مسيرة التحول المعاشة في كنيسة اليوم بعض التردد فالمسألة هي أن نكتشف كيفية “العمل سوياً” للتغلب على هذه الحيرة والتردد. والحقيقة أن بعض أساليب إثبات الذات مازالت تتفاقم لدرجة الصراع وتغلق بالتالي الأبواب أمام التجديد المطلوب.
أما من الناحية العقائدية فقد تم تحديد دور الكاهن في الكنيسة إذ خصص له المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني والكثير من الوثائق البابوية الحديثة أجزاء متكاملة وخاصة تتسق ونور معطيات “التعليم الإيماني” لشعب الله. أما من ناحية الواقع فإن بعض الممارسات هنا وهناك تضع هذه الحقائق موضوع تساؤل أو على الأقل لا تسهل عملية تفهمها وتقبلها. فيجب إذن ألا يعتقد أي منّا بسهولة أن ما يمارسه شخصياً هو ترجمة ناصعة للحقائق الإيمانية العقائدية. إذ كثيراً ما يحدث أن ندافع عن أنفسنا متوهمين أننا ندافع عن الحقائق الإيمانية كما يمكن أن يصل الشطط بالبعض أن يعتبر “نفسه وممارساته الرعوية” حقائق إيمانية لا يصح غيرها وضع كهذا قد يصل بنا إلى نظريات لا تقل خطورة عما تعرضنا له في النفطة الأولى من كتاب الأب مانارنش.
خاتمة:
نود التركيز على هذه النقطة الأخيرة كحقيقة هامة: “لا يمكن الحكم على شيء بصورة تامة” إنه لمن الخطأ أن ننصب من ذواتنا حكاماً ذوي سلطان عالمي على المستوى العقائدي أو الرعوي.
يجب مساعدة الكهنة الشباب على مواجهة الواقع الذي ليس سهل على الإطلاق رغم كونه للكثيرين منهم، ولله الحمد مصدر سعادة روحية، وهنا فإن خبرة الكهنة الأكبر سناً يمكن أن تشكل عوناً ثميناً بالذات من حيث كونها تسمح لهم بالتعمق في عناصر التقليد الكنسي. وعندما يندمج المرء فيه فإما أن يقبل الحدود التي يفرضها هذا التقليد وإما أن يرفضها وينسى حدوده وتقاليده، وهو نسيان مميت وقاتل. وكذلك هي أيضاً الأحكام من طرف واحد والمفترضات التي تولد ذلك. على الجانب الآخر فلا قيام لأي خير في الكنيسة بدون الثقة الكاملة في الأساقفة الذين قبلوا شرعياً تكليف الكنيسة لهم بالقيادة وكذلك في المكونين بالإكليريكيات فحرمان هؤلاء الآخرين من هذه الثقة يعتبر أمراً هداماً داخل الكنيسة.
أخيراً فإنه يجب مساعدة الكهنة الشباب في التلاقي والتفاهم المشترك بينهم لأن النقاش والجدل ليس قائماً فقط بين الكهنة الشباب والكهنة المسنين ولكنه موجود أيضاً بين الشباب بعضهم وبعض، فعلى وحدة إكليروس الغد تتوقف وحدة الكنيسة مستقبلاً.
الأب برنار بيتو
رئيس الإكليريكية الجامعية بباريس
المرجع:
عن مجلة صديق الكاهن لسنة 1995