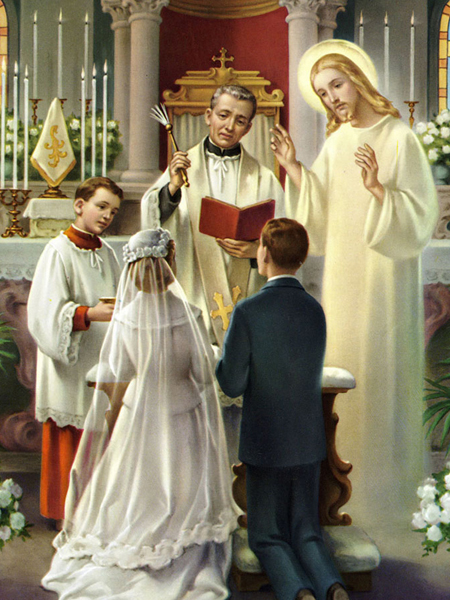يرى بعض اللاهوتيين البروتستنتيين من أمثال كارل بارت ورودولف بولتمن ان الانسان لا يمكنه معرفة الله إلا إذا أوحى الله له بذاته. وقد تمّ هذا الوحي في الكتاب المقدّس الذي هو وحده كلام الله وفيه وحده يستطيع الانسان أن يعرف الله معرفة حقيقية. وكل ما يقوله الانسان عن الله خارجاً عن وحي الله لذاته في الكتاب المقدّس ليست سوى صورة مزيّفة للإله الحقيقي، لأنه مجرّد انعكاس لرغبة الانسان في الارتفاع من واقع ضعفه وحدوده إلى المطلق الأسمى. ان الخوف من أن يؤلّه الانسان صورة رغباته البشرية هو الذي حمل كارل بارت على رفض كل معرفة لله خارج الوحي. لا ريب في أن هذا الخوف له ما يبرّره. غير أن الايمان بالله، وان ارتكز على الوحي، لا بدّ له من الاستناد أيضاً إلى خبرة انسانية ومعرفة بشرية، وإلا أصبح افتراضاً لا أساس له أو مجرّد وهم أو شريعة تفرض من الخارج ويحتّم على الانسان القبول بها دون محاولة تفهّمها. فالايمان لا يمكن أن يكون إيماناً أعمى بل هو إيمان مسؤول. لذلك لا يفرض الايمان على الانسان من فوق، بل يتّخذ كل مؤمن قرار الايمان انطلاقاً من خبرة شخصية متّصلة بواقع حياته. ب- البراهين التي تستند إلى الطبيعة والعالم والمخلوقات يعتقد اللاهوت الكاثوليكي التقليدي أن الانسان يستطيع التوصّل إلى معرفة الله من خلال الكون والطبيعة وسائر المخلوقات. فالتأمّل بالمخلوقات وبما فيها من جمال ونظام يمكن أن يقود إلى الاعتراف بوجود إله خالق خلقها ووضع ما فيها من جمال ونظام. ويرتكز اللاهوتيون الكاثوليكيون في تحليلهم على البراهين الفلسفية لوجود الله التي وضع أُسسها أرسطوطاليس وأفلاطون، وأدخلها القديس اغوسطينوس في اللاهوت، ثم نظّمها وتوسّع فيها القديس توما الاكويني. وقد عالج المجمع الفاتيكاني الأول (سنة 1870) هذا الموضوع وأخذ بنظريّة توما الاكويني بعد أن أدخل عليها بعض التعديل. فبينما يقول توما الاكويني إن العقل البشري يمكنه مبدئياً أن يبرهن عن وجود الله، اكتفى المجمع بالقول إن الانسان يمكنه مبدئياً أن يعرف الله، ويضيف أن هذه الامكانية المبدئية قد أصبحت واقعاً بفضل وحي الله. وتبنّى المجمع الفاتيكاني الثاني أيضاً هذا الموقف في “الدستور العقائدي في الوحي الالهي” (سنة 1965)، الذي يعلن فيه “ان العقل البشري يستطيع بنوره الطبيعي أن يعرف الله مبدأ كل شيء وغايته معرفة أكيدة، وذلك عن طريق المخلوقات”. ويستشهد بما يقوله بولس الرسول في رسالته الى الرومانيين (1: 20) “ان صفات الله غير المنظورة، ولا سيمَا قدرته الأزلية وأُلوهته، تبصر منذ خلق العالم، مدركة بمخلوقاته”. ثم يضيف المجمع: “إلا أنه من الواجب أن يُعزَى إلى الوحي أن الأمور الإلهية التي ليست في حدّ ذاتها صعبة المنال على عقل الانسان، يستطيع الجميع، حتى في ظروف الجنس البشري القائمة، أن يعرفوها بسهولة، وأن يتيقّنوا منها يقيناً ثابتاً لا يخالطه غلط” (رقم 6). ان هذا الموقف، الذي دُعي باللاهوت الطبيعي، هو حلّ وسط بين موقف العقلانيين الذين ينكرون الوحي ولا يرون في الايمان إلا عملاً عقلياً، وموقف الذين يرفضون الارتكاز على أي معرفة عقلية لله ولا يرون في الايمان إلا استسلاماً لله ولكلامه. ويؤكد اللاهوت الطبيعي أن هناك نوعين من المعرفة: معرفة طبيعية ترتكز على العقل البشري، ومعرفة فائقة الطبيعة ترتكز على الوحي والايمان. فالمعرفة الطبيعية هي نقطة الانطلاق التي يوجد فيها الانسان عندما يسمع كلام الوحي. عندئذٍ ينتقل من المعرفة العقلية إلى الايمان. ان السبيل إلى الله من خلال الكون والطبيعة والتفكير العقلي لا يزال يعتمده الكثيرون من اللاهوتيين المعاصرين. إلا أن كثيرين غيرهم، وعددهم يزداد يوماً بعد يوم، يرون أن البراهين العقلية عن وجود الله قد ضعفت قدرتها على الاقناع، ولا سيمَا بعد ما أظهر الفيلسوف الالماني كانط حدود العقل البشري وعدم قدرته على تأكيد أي شيء يخرج عن نطاق الطبيعة والخبرة الانسانية. فالعقل لا يمكنه، في نظر كانط، أن يقدّم براهين جازمة عن وجود الله ولا عن عدم وجوده. لا شك أن كانط يصل إلى الايمان بوجود الله عن طريق أخرى. فيقول إن تأكيد وجود الله هو من المسلّمات التي يفترضها الانسان ويقبل بها انطلاقاً ما يشعر به في داخله من واجب يدفعه إلى عمل الخير ومن رغبة في السعادة اللامتناهية مرتبطة بتتميم هذا الواجب. فالشعور بالواجب غير ممكن إن لم يكن هناك إله يفرض هذا الواجب. والرغبة في السعادة غير ممكنة إن لم يكن هناك إله يشبع تلك الرغبة ويكافئ بالسعادة الأبدية من يصنع الخير في حياته على الأرض. غير أن تلك المسلَّمات، كما يرى بعض اللاهوتيين المعاصرين، هي أيضاً بحاجة إلى إثبات، ولا يمكنها بالتالي أن تقود إلى تأكيد وجود الله. ج- السبيل إلى الله من خلال خبرة الانسان * القلق الوجودي ان من ينظر إلى ما يختبره الانسان في واقع حياته يرى أن الانسان يعجز دوماً عن تحقيق ما تصبو إليه نفسه، وأن هناك تبايناً مستمراً بين ما يريد أن يكون وما هو عليه في الواقع. يريد كياناً مطلقاً ووجوداً خالداً ولا يختبر إلا كياناً محدوداً ووجوداً مائتاً، يريد حياة مليئة بالقيم ولا يختبر إلا الفراغ والعبث، يريد عمل الخير وراحة الضمير ويصطدم بالشرّ والشعور بالذنب. ونتيجة لتلك الخبرة يساوره الخوف وينتابه القلق. لقد أوجز اللاهوتي الالماني “بول تيليخ” (1886- 1965) حالة الانسان هذه في كتاب دعاه “الجرأة على الكيان”، ميَّزَ فيه ثلاثة أنواع من الخاطر تهدّد كيان الانسان في أبعاده الثلاثة: – فالمصائب والموت تهدد الانسان في حياته ووجوده، – والشعور بالفراغ والعبث يهدّدان كيانه الروحي، – والشعور بالذنب والهلاك الأبدي يهدّدانه في كيانه الأدبي وتكون هذه المخاطر نسبية أو مطلقة وفقاً لما تحدثه من دمار في كيان الانسان: فالمصائب والأمراض تهدّد حياة الانسان تهديداً نسبياً، أما الموت فيقضي عليها نهائياً، والفراغ يهدّد كيان الانسان الروحي تهديداً نسبياً، وأما العبث فيقضي عليه نهائياً؛ والشعور بالذنب يهدّد كيان الانسان الأدبي تهديداً نسبياً، أما الهلاك الأبدي فيقضي عليه نهائياً. والقلق الذي يعانيه الانسان ينتج ما يشعر به من خوف حيال تلك الخاطر. لذلك يكون هو أيضاً إما قلقاً نسبياً وإما قلقاً مطلقاً. * السيطرة على القلق بعد هذا التحليل للوضع الانساني، يصف تيليخ كيف يتمكّن الانسان من السيطرة على القلق. فيرى أن الانسان لا يمكن أن يبقى في الوجود رغم ما يهدّد كيانه من مخاطر إلا إذا كانت له “الجرأة على الكيان”. وتلك الجرأة يستمدّها الانسان من مصادر ثلاثة: من المجتمع ومن ذاته ومن الله. فالانسان يشعر بأنه جزء في مجتمع يتفاعل معه فيعطيه ويأخذ منه ويجد فيه الراحة لنفسه والمعنى لحياته. كما يشعر الانسان انه شخص له كرامته وهدف يسعى إليه وفيه يحقّق ذاته. وبقدر ما يندمج الانسان في المجتمع ويحقّق فيه ذاته بقدر ذلك يمكنه أن يتغلّب على ما يهدّد وجوده من مخاطر وما يعانيه في كيانه من قلق. إلا أن تلك الجرأة التي يستمدّها الانسان من المجتمع ومن ذاته لا تقوى على السيطرة إلا على المخاطر النسبية التي تهدّد كيان الانسان في مختلف أبعاده وعلى ما ينتج عن ذلك من قلق نسبي. فأي قوة يستطيع الانسان أن يجدها في ذاته أو في المجتمع للسيطرة على القلق الذي يشعر به إزاء الموت والعبث والهلاك الأبدي؟ في تلك الحالات القصوى، يقول تيليخ، لا يبقى للانسان إلا ملجأ واحد يلجأ إليه، وهو الايمانُ بوجود حقيقة قصوى تفوق الطبيعة وتسمو على الكون، والاعترافُ بوجود كائن مطلق يستطيع أن يرتمي في أحضانه بثقة كاملة. وحده الايمان بالكائن المطلق يمكّن الانسان من التغلّب على القلق المطلق الذي يعانيه حيال المخاطر التي تهدّد كيانه تهديداً مطلقاً في مختلف أبعاده. * التغرّب والضياع ان هذا القلق الوجودي العميق، إن لم يتمكّن الانسان من السيطرة عليه، لا بدّ من أن يقوده إلى التغرّب. والضياع. التغرّب والضياع كلمتان لمفهوم واحد تردان كثيراً في الفلسفة المعاصرة للتعبير عن حالة الانسان الذي يعيش غريباً عن نفسه وعن الآخرين، ضائعاً في عالم وُجد فيه دون أن يعرف من أين أتى وإلى أين هو ذاهب. يقول شارل مالك في وصف تغرّب الانسان: “غريب هو الكائن الانسان -غريب في امتلائه سراً وغرابة، وغريب هو في كونه متغرّباً- غريب متغرّب. وسرّ أسراره يكمن في ذلك التغرّب إياه. لذلك نسأل: متغرّب عن ماذا؟ متغرّب عن مَن؟ ونجيب انه متغرّب عن شيء كانه أو بإمكانه أن يكونه، لكنه، وهو في حالة التغرّب هذه، يكون دون ذلك الشيء أو بعيداً عنه، وحنينه الأخير هو في الرجوع إليه. فغرابة الانسان، إذن، هي في كونه متغرّباً عن شيء يحنّ للرجوع إليه. كلّنا غرباء. أنا أعرف تماماً أيّ غريب، وأزعم، أيها القارئ، أنك أنت أيضاً غريب. غرابتك انك طافح بالأسرار التي أجهل، بل، والتي تجهل أنت أيضاً. وهذا هو الأغرب. غرابتك انك تجيش بالمهام التي لست واثقاً منها أنت نفسك. انك مثلي، تتلمّس أسرارك ومعنى حياتك كلها في هذا التلمّس. ان سرّك الدفين هو أنك تريد، مثلي، إنهاء تغرّبك والعودة إلى كيانك، وتفتّش، مثلي، عن طريق العودة. متى نعود؟ وكيف نعود؟ وإلى أين بالذات؟ وإلى مَن؟ ثم هل نستطيع العودة؟ أم انه قُضي علينا بالتغرّب طيلة العمر؟ وهل من طبيعة كياننا أن نبقى غرباء، نعاني حسرات الغربة؟ تلك هي الأسئلة الأخيرة الحاسمة… ” التغرّب اذاً هو حالة الانسان العائش غريباً عن غاية وجوده، بعيداً عن معنى حياته. ولن يستطيع إنهاء تغرّبه والعودة إلى كيانه ما لم يجد غاية وجوده ومعنى حياته. كيف السبيل إلى ذلك؟ * اكتشاف القيمة القصوى في وجود كل انسان قيم متعدّدة يسعى إلى تحقيقها لأنه يرى في ذلك تحقيقاً لذاته. وتختلف هذه القيم باختلاف الحاجات والرغبات والأطباع والأميال. فهناك حاجات بيولوجية لا بدّ من إشباعها كالحاجة إلى الطعام والكسوة والمسكن، وهناك حاجات فكرية كالحاجة الى المعرفة والجمال؛ وهناك حاجات اجتماعية كالحاجة إلى عائلة ومجتمع ووطن. ويختلف البحث عن تلك القيم باختلاف أهميتها. فمن القيم ما هو أساسي في حياة الانسان ومنها ما هو ثانوي. وفي الواقع لكل إنسان سُلَّم من القيم يبنيه هو نفسه، وفي أعلى هذا السُلَّم يضع قيمة أساسية قصوى، كالحب، والصداقة، والمال، والشرف، والسلطة، والمكانة الاجتماعية، والحزب، والوطن، الخ… وهذه القيمة القصوى هي التي تعطي معنى لوجود الانسان وتساعده على تحمّل صعوبات الحياة والتغلّب على ما يعانيه من حيرة وقلق. لذلك يوجّه إليها كل قواه، ولا ينظر إلى الحياة إلا من خلالها، ولا يبحث عن سائر القيم إلا بقدر ما تتيح له تحقيق تلك القيمة القصوى، لأنه يرى في تحقيقها تحقيقاً لذاته، وفي فقدانها فقداناً وضياعاً لذاته، فهي محور نظرته الى الكون والواقع، ومركز ائتلاف كيانه وشخصيته. معظم الناس يختارون لذواتهم قيمة قصوى يسعون لتحقيقها في حياتهم، ولكن المهم في الأمر ليس الاختيار بل حسن الاختيار. ومشكلة الانسان الكبرى، التي هي في أساس تغرّبه، هو انه، في معظم الأحيان، يخطئ في اختياره. يختار لنفسه قيمة قصوى من بين هذه الأمور التي تشبع رغباته الوقتية وحاجاته الزمنية، ولكنها لا تقوى على إشباع رغبته في المطلق وعطشه وإلى اللامتناهي، ولا تستطيع من ثَمَّ إزالة الخاطر المطلقة التي تهدّد الانسان في عمق كيانه: خطر الموت وخطر العبث وخطر الهلاك الأبدي. لذلك ان اكتفى بها الانسان ووضع فيها رجاءه الأخير، لا بدّ له من الشعور بخيبة الأمل وبالتغرّب عن غاية وجوده ومعنى حياته. ان الأمر الوحيد الذي يستطيع أن يكون الغاية القصوى الحقيقية للانسان يجب أن يصحّ فيه ما يقوله أيضاً شارل مالك عن الحقيقة: “انه شيء موجود، شيء حقيقي ثابت وأكيد، لا غشّ فيه ولا زيف، شيء لا يخدع ولا يغالط، وهو، على بعده وخفيته، شيء متاح، ممكن الأخذ والمنال، شيء يرتاح إليه العقل ويطمئنّ تماماً، بل ليس في مقدور العقل أن يشكّ فيه، أو يتساءل عنه، أو يدور حوله، انه شيء يقنع ويشبع، شيء مضبوط لا عطب في أيّ من جوانبه كافة، يملأ النفس، فتطمئنّ إليه، وتجد فيه سعادتها، شيء باقٍ أركن إليه بسلام، وهو حين أجده أقول انه كان موجوداً منذ الأزل وهو الذي كنت أبحث عنه طيلة حياتي؛ شيء يغنيني عن أيّ شيء آخر إن أنا وجدته ومكثت فيه؛ شيء مباح عمومي بمقدار ما هو خصوصي أمتلكه شخصياً، شيء إن أنا حزته واعتنقته تمكّنت من شرحه ونقله إلى غيري، وتمكّن غيري من حيازته واعتناقه هو أيضاً، دون أن ينتقص مثقال ذرّة من حيازتي له واعتناقي إياه، شيء بقدر ما أشرحه وأكونه وأشهد له، وأشرك فيه غيري، بقدر ما يزداد فيّ تمكّناً ووثوقاً”. ولكن هل من سبيل للتأكد من وجود هذا الكائن المطلق