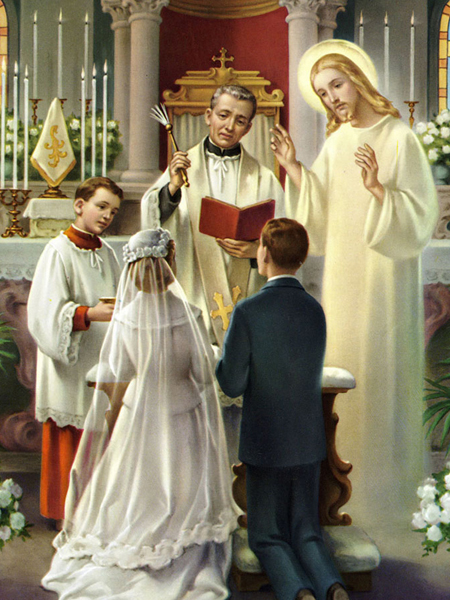بقلم الأب فرنسوا عقل المريمي
روما، الخميس 22 أكتوبر 2009 (Zenit.org).
السّياسة الحقيقيّة مسألة شريفة جدّا، والكنيسة جماعة رجاء هدفها سامٍ جدّا! فالسّياسة تتناول علاقة الإنسان بالإنسان، أمّا الكنيسة فتربط الإنسان بالله أوّلا. لكنّ ميزة السّياسة الحقيقيّة قبل كلّ شيء -وهذا ما يجعلها تتلاقى أحيانا مع الكنيسة-، هي الارتكاز على أسس خلقيّة واضحة. كما أنّ ما يهمّ الكنيسة في ذلك، هو الذّود عن مبادئ الأخلاق السّياسيّة، كحاجة أساسيّة في بناء الدّولة الحديثة. فالشّخص البشريّ هو ركن السّياسة وموضوعها وغايتها، وحرّيته من حرّيّة المجتمع المدنيّ. لذا على السّياسة بادئ ذي بدء، أن تبحث بصورة دائمة عن معناها الحقيقيّ أي "الفنّ الصّعب والنّبيل" الذي تحدّثت عنه بإسهاب الفلسفة اليونانيّة، لا أن تكون كما هي اليوم في الكثير من دول العالم، "فنّ الخداع" على حدّ قول فولتير Voltaire إذ "تجد لها ميدانا فسيحا في العقول الضّعيفة" ( راجع، جهاد نعمان، حقوق الإنسان في العالم العربيّ، جونيه 1992، ص. 87). غير أنّ ذلك يحتاج إلى تحضير دؤوب على مستوى التّربية المدنيّة والسّياسيّة.
كان لا بُدّ لنا في معالجتنا هذا الموضوع، من الاستناد بصورة خاصّة، على الفصل الرّابع من القسم الثّاني من وثيقة "فرح ورجاء"، التي هي بمثابة دستور رعويّ يتمحور حول الكنيسة في عالم اليوم، وهو -إن جاز التّعبير-، مختصَر مفيد لأعمال المجمع الفاتيكانيّ الثّاني وتوجّهاته، إذ يعكس إرادة الكنيسة بالانفتاح والحوار مع كلّ متطلّبات العالم المعاصر، وتعليمها الاجتماعيّ وموقفها من الجماعة السّياسيّة وكيفيّة التّعامل معها.
I. الجماعة السّياسيّة
ليست الدّولة في المفهوم الحديث، حكراً على الوالي كما كانت في الأزمنة الخوالي؛ ولم يعد المَلِك هو نفسه الدّولة، كما قال ذات يوم لويس الرّابع عشر المعروف بِمَلك الشّمس “Roi Soleil”: "الدّولة هي أنا" "L’Etat c’est moi". بل الدّولة اليوم، هي الحكّام والمواطنون، الذين يؤلّفون معا ما ندعوه بالجماعة السّياسيّة التي ليست هي بمجموعة من القادة أو السّياسيّين وحسب، بل كلّ من يعيش على أرض الوطن وينتمي إليه؛ والمواطنون أنفسهم هم الذين يجب أن يحدّدوا نظام الحكم السّياسيّ وأن يختاروا قادتهم (ك ع 74) ( سوف نستعمل في سياق البحث المصطلح (ك ع) للدّلالة على وثيقة فرح ورجاء)، في فلسفة الدّولة المدنيّة المعاصرة، وذلك لسبب بسيط هو أنّ الدّيموقراطيّة هي حكم الشّعب.
وعليه، تتألّف الجماعة السّياسيّة من الحكّام أي السّلطة السّياسيّة ومن المواطنين (ك ع 76)؛ وانطلاقا من تحديد السّياسة الحقيقيّة بالفنّ النّبيل، نجد أنّ هذا الفنّ لا تمكن ممارسته إلاّ وسط جماعة سياسيّة تكون بمثابة واقع طبيعيّ جوهريّ للنّاس، غايتها الأولى تحقيق الخير العام، عبر احترام الحرّيّة وتنمية البعد الدّينيّ في المجتمع، لأنّ قيمة الشّخص البشريّ، تبقى دائما فوق كلّ اعتبار كنقطة انطلاق جوهريّة، ومن ثمّ قيمة الجماعة البشريّة برمّتها (Cf. G. Campanini, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes, Casa Monferrato 1986, p. 169).
II. السّلطة السّياسيّة
تدعى أيضا "الحكم"، هي عنصر تأسيسيّ وتنظيميّ في الدّولة؛ ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى موقف الكنيسة منها. مصدر السّلطة السّياسيّة من حيث المبدأ، بالنّسبة إلى الكنيسة هو الله. "فلا سلطة إلاّ من الله، والسّلطات القائمة هي من تدبير الله" (روما 1:13)، ولكن هذا لا يعني أنّه يوافق على أداء جميع القيّمين على مقدّرات الحكم في العالم. فالله لا يرضى إلاّ على الحاكم الذي يرضي ضميره أي صوت الله فيه، والذي يحكم بعدل وتفان مؤثرا الخير العام على مصالحه الشّخصيّة.
إنّها ضرورة مطلقة للجماعة السّياسيّة؛ لكنّ ممارستها بنُبل لا يمكن أن تتمّ خارج إطار الشّريعة الأدبيّة، في سبيل تحقيق الخير العام، حيث الأفراد والعائلات والجمعيّات والجماعات يستطيعون العيش بسلام واستقرار وكرامة، عبر تفاعلهم الإيجابيّ في مشاركتهم بشؤون الدّولة، كلّ حسب دوره وحجمه وموقعه؛ لأنّ الكلّ معنيّ في مشروع سير رَكْبِ الدّولة نحو التّقدم والنّموّ والازدهار.
فالسّلطة الحقيقيّة هي "خادمة لله في سبيل الخير" (روما 4:13)؛ وهي "تكرّس" لخدمة الوطن ولتحقيق مصالحه العامّة من قِبل المواطنين الذين يشاركون فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ومن قِبل الحكّام الذين يتولّون السّلطة بصورة مباشرة، بعيدا عن كلّ مطمع في مركز أو رفعة وحبّ ظهور، وانتهاز الفرص السّانحة لكسب المال المشروع أو غير المشروع (ك ع 75). لكنّ المسؤوليّة العظمى تقع على عاتق أهل السّلطة أنفسهم، فإذا تجاوزوا صلاحيّاتهم وظلموا مواطنيهم، لا يمكن لأحد حينئذ أن يمنع المواطنين من الدّفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم بالطّرق المشروعة، لأنّ أيّ خلل في إدارة شؤون الدّولة هو خطر على الخير العامّ في الوطن. وقد صف البابا السّابق يوحنّا بولس الثّاني، الرّجلَ السّياسيّ المثاليّ، بذاك الذي يعمل على نحو مستقيم، بتكامل خلقيّ والتزام حيويّ ضدّ كلّ ما هو مناف للعدالة؛ فالنّظام الذي تدعو إليه كنيسة المسيح هو نظام حبّ وعدل (Cf. Avvenire, 01, 05, 2003, p.1).
أمّا الخير العام، بمفهومه الحصريّ، فهو مبدأ خلقيّ سياسيّ يحدّد الشّروط الرّوحيّة والمادّيّة التي يقوم عليها المجتمع في سبيل نموّ أفراده واتّساع أفق الحرّيّة فيه، من خلال الاحترام الواجب للشّخص البشريّ كقيمة أساسيّة لتحقيق العيش بسلام مع الآخرين. بدون أن ننسى أنّ المسيحيّ يؤمن بالخير العام الحقيقيّ الذي هو ملكوت الله. ناهيك عن أنّ طبيعة الجماعة السّياسيّة وهدفها يتّجهان نحو تحقيق الخير العام بمفهومه المدنيّ (Cf. G. F. Svidercoschi, Storia del Concilio, Milano 1967, P. 645).
III. أنماط الحكم السّياسيّ
من المعروف في حقل القانون العام، أنّ شكل النّظام السّياسيّ للدّولة هو عبارة عن مجموعة من المبادئ التي يستوحي منها الدّستور أحكامه، في سبيل تنظيم علاقة الدّولة بمواطنيها.
وفي هذا السّياق، تبدو اليوم عقيمة أو قل محدودة الأفق، تلك الأنظمة التّوتاليتاريّة التي يستأثر فيها حزب واحد بزمام الحكم، أو ينفرد بالتّصرّف المطلق بها من يُسمّى بالرّئيس "الموهوب" فيقوّض الحرّيّات وحقّ الاختيار الحرّ عند المواطنين بحكمه الأمنيّ أو البوليسّي أو الدّكتاتوريّ الذي ينتهك حقوق الأشخاص والمجتمع. لذلك، تشجب الكنيسة كلّ نظام دكتاتوريّ (ك ع 75)؛ لكنّها لا تؤيّد النّظام الدّيموقراطيّ بصراحة أو بصورة مباشرة في وثيقة "فرح ورجاء"، إذ لم تأت هذه الأخيرة على ذكره، لكنّها تفضّل ضمنا جميع مقوّماته، برفضها سائر الأنظمة التي تتنكّر للحرّيّات المدنيّة والدّينيّة، ممّا يثبت أنّ الكنيسة لا تهتّم فقط بحّريّتها الخاصّة أو بالحرّيّة الدّينيّة وحريّة الضّمير فحسب، بل بحريّة البشر جميعهم.
IV. المواطنون الكاثوليك
الشّعب هو أيضا عامل أساسيّ في مقوّمات الدّولة؛ إنّه جماعة أفراد مواطنين يتعايشون ويعملون في سبيل تحقيق الخير العام -"فإنّ من يعمل الخير لا يخاف الحكّام" (روما 3:13)-، وبالتّالي، يقع عليهم واجب حبّ الوطن بدون مواربة (ك ع 75)؛ والمواطن الصّالح هو مَن لا يفضّل أبدا، منفعته الخاصّة على مصلحة الوطن.
لنحصرنّ الحديث هنا في المواطن الكاثوليكيّ. فبما أنّ حضوره في الحقل المدنيّ، شخصيّ ومستقلّ ومسؤول، ينبغي له أن يمارس دوره في الدّولة بصفة شخصيّة، وليس باسم الكنيسة (Cf. A. Ferrari-Toniolo, “Guida allo studio della Costituzione pastorale”, in Il Concilio Vaticano II, vol. IV, Roma 1966, p. 290). هَمّ المواطن الكاثوليكيّ يجب أن يكمن في محاولاته المستمرّة لجعل النّظام الاجتماعيّ في الدّولة أكثر إنسانيّة، من خلال تحسين الخير العام عبر تعزيز الحرّيّة واحترام القوانين والكرامة والمسؤوليّة، والابتعاد عن الفوضى والغشّ وأعمال الفساد وجميع ألوان التّعصّب المنغلق، والتطرّف الأعمى، والرّفضيّة المتخلّفة، عن طريق التّحلّي بالنّزاهة والاعتدال واحترام الاختلاف بالرّأي والمعتقد. كما يجب التّخلّي عن منطق "التّعصّب الوطنيّ" (Nationalisme) المتقوقع، والتّربية على مفهوم "محبّة الوطن" (Patriotisme)المنفتحة والبنّاءة.
لهذا السّبب، نعتقد أنّه من الضّروريّ تطوير نمط جديد من التّربية المدنيّة العالميّة المشتركة، قد تقرّرها وتصدرها هيئة الأمم المتّحدة على منوال شرعة حقوق الإنسان مثلا، تساهم في فهم المعنى الحقيقيّ للعدالة الشّاملة، وعمل الخير الموضوعيّ، وقواعد خدمة المجتمع، وكيفيّة المشاركة المسؤولة في الشّأن العام، وممارسة السّياسة بتجرّد وتفان.
V. علاقة الدّين بالجماعة السّياسيّة
إنّ الدّين المسيحيّ في معناه اللاهوتيّ ولو كان هدفه ربط الإنسان بالله كما أسلفنا، لا يقتصر فقط على مجموعة من المعتقدات والحقائق الإيمانيّة والمسلّمات اللاهوتيّة، بل ينطلق أيضا من "الجماعة البشرية المنظورة" فيناضل من أجلها في المكان والزّمان، في التّاريخ والجغرافية، Hic et nunc "هنا" و "الآن"، ساعيا إلى بناء مملكة عدالة ومحبّة وحرّيّة حقيقيّة في العالم، مستفيداً من الوسائل الزّمنيّة الخيّرة، بقدر ما تتطلّبه رسالته السّامية. إلاّ أنّ هذه المملكة المرتجاة، ليست دولة بالمعنى السّياسيّ. فالمسيحيّة ليست دينا ودولة؛ والإسلام على ما نعرف هو دين ودنيا لا دين ودولة. كما أنّ ثمّة فرق بين اليهوديّة كديانة سماويّة، والصّهيونيّة العالميّة التي لا تمتّ للدّين بصلة.
فلا يختلطنّ الدّين، بحال من الأحوال بمبادئ السّياسة وتشعّباتها! ولا يرتبطنّ اللاهوت بأيّ نظام سياسيّ، لأنّ الدّين حياة وروح، وهو العلامة والضّمانة لما يمتاز به الشّخص البشريّ من تسام وتوق إلى "مدينة الله" أو "الجنّة" أو "الفردوس" أو "أورشليم السّماويّة" أو "ملكوت السّماوات".
وعليه، فإنّ الجماعة السّياسيّة والكنيسة مستقلّتان، لا ترتبط الواحدة بالأخرى في الحقل الخاصّ لكلّ منهما (ك ع 76). فالدّولة هي مجتمع مدنيّ ذو بعد أفقيّ والكنيسة هي مجتمع إيمانيّ ذو بعد عموديّ-أفقيّ أي روحيّ واجتماعيّ؛ تتألّف الأولى من مواطنين وتتكوّن الثّانية من معمّدين. تُعنى الأولى في خدمة الخير العامّ الأفقيّ وحسب، فيما تهتمّ الثّانية بالخير العامّ العموديّ الذي هو "خلاص النّفوس" من جهة، والأفقيّ أي نشر المحبّة والعدالة والتّسامح والقيم الخلقيّة من جهة أخرى، إذ لا ينبغي لها "أن تفعل هذه وتترك تلك".
لذا وجب على المؤسّستَين المستقلّتين، أن تتعاونا تعاوناً صادقاً وسليماً من أجل خير الجميع؛ فتنميان معا وتتكاملان، من دون أن تذوب الواحدة في الأخرى. فالكنيسة تخدم الدّولة لأنّ رسالتها تكمن في نشر القيم والمحبّة والأخلاق في المجتمع، وتتناول خير جميع قطاعات النّشاط البشريّ، وتحترم مسؤوليّة المواطنين وحرّيتهم، وتعمل على رفع اسم الوطن عاليا، كما أنّ سياسة الدّولة يجب أن تحترم حرّيّة الكنيسة ومعتقداتها ورسالتها وطقوسها واستقلاليّتها.
غير أنّ الكنيسة من جهتها، تتمسّك بحقّها في إصدار حكمها الأدبيّ حتّى في القضايا التي لها علاقة بالشّأن السّياسيّ، إذا تطلّبت ذلك حقوق الشّخص الأساسيّة بما فيها خلاص النّفوس، مستخدمة مختلف الوسائل الملائمة للإنجيل وخير الجميع (ك ع 76)، لأنّ ما يعنيها هو دورها الخلُقيّ في الشّأن العام عبر سلطتها التّعليميّة التي تلزم ضمائر أتباعها، بالعمل في الحقل العام الاجتماعيّ والسّياسيّ، على ضوء تعاليمها وتوجيهاتها. ففي هذه الحالة فقط، على الكنيسة أن تتمسّك بحقّها في إصدار حكمها الأدبيّ في القضايا التي لها علاقة بالشّأن السّياسيّ.
VI. الحرّيّة الدّينيّة والمدنيّة
لا يمكننا البحث في مسألة الكنيسة والسّياسة من دون التّوقّف ولو مليّاً أمام موضوع الحرّيّة الدّينيّة. فهي حقّ من الحقوق الأساسيّة للشّخص البشريّ، لممارسة دينه ومعتقداته حسب متطلّبات ضميره. لذلك، من الضّرورة بمقدار، تجنّب الخلط بين الحرّيّة الدّينيّة وعدم الاكتراث للدّين، أو العلمنة السّلبيّة أو "النّسبيّة الاعتقاديّة".
لذلك، يجب أن تُحترَم الحرّيّة الدينيّة من الجميع، لأنّ ما من سلطة بشريّة تستطيع أن تحلّ مكان ضمير الإنسان الذي له وحده حرّيّة القرار عبر الانسجام مع مستوجبات الحقّ الإلهيّ.
فالكنيسة لا تدافع فقط عن حرّيّة الرّأي بل عن حرّيّة الشّخص بممارسة معتقده الخاصّ والعامّ أمام الله والنّاس؛ لذا على السّلطة المدنيّة الاعتراف بحقّ الحّريّة الدّينيّة وضمانة ممارستها من قبل جميع المواطنين. كما أنّ للدّولة حقّ الحماية الخاصّة من سوء استعمال البعض للحرّيّة الدّينيّة (Cf. G. F. Svidercoschi, Storia…, pp. 555-559).
والكنيسة التي تؤيّد كلّ نظام سياسيّ يحافظ على حرّيّة الأشخاص وحقوقهم وسط الحياة العامّة، تشجب كلّ الأنظمة التي تقف حاجزا في وجه الحرّيّة الدّينيّة والمدنيّة، كما يحصل في بعض البلدان حيث يتحوّل عمل السّلطة لمصلحة البعض أو لمصلحة الحكّام أنفسهم عوضا من أن يكون في خدمة الخير العام.
خاتمة:
لم يعد همّ الكنيسة بعد "الفكر الكنسّي الجديد" الذي أطلقه المجمع الفاتيكانيّ الثّاني، التدخّل في الشّؤون السّياسيّة، بل ما يعنيها هو دورها الخلُقيّ في الشّأن العام، وسلطتها التّعليميّة، Potestas magisterii، التي تلزم ضمائر المواطنين الكاثوليك، بمعطاة الشّأن العام الاجتماعيّ والسّياسيّ، على ضوء تعاليمها وتوجيهاتها.
إنّ هذه السّلطة الأدبيّة أو الخلقيّة هي تطبيق لما قاله البابا بيوس الثّاني عشر قبل انعقاد المجمع المسكونيّ: "ما من سلطة بشريّة، وما من دولة، وما من مجموعة دول مهما كان طابعها الدّينيّ، يحقّ لها أن تسمح بالتّعليم أو العمل بخلاف الحقيقة الدّينيّة والخير الأدبيّ" (AAS, 20 (1953) 798).
يبقى لنا أن نؤكّد أخيرا، أنّه من الضّرورة بمقدار، تعزيز مفهوم التّعاون السّليم المتبادَل، بالنّسبة إلى كلّ "الأمور المشتركة" بين المؤسّستين السّياسيّة والكنسيّة Una sana cooperatio in materiae mixtae.
ففي ذلك فقط، يتحقّق الانسجام المنشود بين الكنيسة والدّولة، ويلتقي الكرسيّ الأسقفيّ بكرسيّ الرّئاسة، وتتّحد غاية الكنيسة التي هي "خلاص النّفوس" Salus animarum، مع هدف الدّولة الذي هو الخير العام.
* * *
الأب فرنسوا عقل، راهب مارونيّ مريميّ يعمل في مجمع الكنائس الشّرقيّة في الفاتيكان، حائز على دكتوراه في القانون الكنسيّ، من جامعة مار يوحنّا اللاتران الحبريّة في روما، وبكالوريوس في الفلسفة واللاهوت من جامعة الرّوح القدس –الكسليك- في لبنان، وجامعة مار يوحنّا اللاتران الحبريّة في روما، ودبلوم في الدّراسات العربيّة والإسلاميّة، في المعهد البابويّ للدّراسات العربيّة والإسلاميّة في روما. من مؤلّفاته: "شِعْر وْصَلا"، صدر عام 2001، و"أضواء على العلاقات السّياسيّة والقانونيّة بين البطريركيّة المارونيّة والدّولة اللّبنانيّة"، صدر عام 2007.